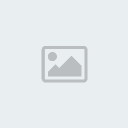مايكل عادلعضو نشيط
مايكل عادلعضو نشيط
 الرسالة العامة (بالرجاء مخلصون) 10 البابا بندكتس
الرسالة العامة (بالرجاء مخلصون) 10 البابا بندكتس
الأربعاء مايو 14, 2008 4:11 pm
ثالثاً: الدينونة الأخيرة، كمكان لفهم وممارسة الرجاء
41- يتحدَّث قانون إيمان الكنيسة في جزئه المحوري عن سرّ المسيح منذ ولادته الأزلية من الآب إلى ولادته الزمنية من العذراء مريم ليَصلَ مروراً بالصليب إلى القيامة حتى عودته، ويختم بالعبارة: «... سيأتي من جديد ليدين الأحياءَ والأموات». لقد أثَّرت فكرة الدينونة الأخيرة، منذ الأزمنة الأولى، على المسيحيين حتى في حياتهم اليومية، فكانت لهم بمثابةِ مقياسٍ لتنظيم حياتهم الحاضرة، ونداءٍ لإتباعِ الضمير وفي نفس الوقت كانت لهم رجاءً في عدل الله. إنَّ الإيمانَ بالمسيح لَمْ ينظر أبداً إلى الوراء فحَسْب، ولا إلى العَلاء فحَسْب، بل هو ينظرُ على الدوام إلى الأمامِ أيضاً، إلى ساعةِ العدلِ التي كان الربُّ قد سبقَ وأعلنها مراراً. هذه النظرة إلى الأمام قد أضفَتْ على المسيحيةِ أهميتها الخاصة بالنسبة للحاضر. أرادَ المسيحيون عن طريق تنسيقِ دور العبادة، أن يُظهِروا البُعد التاريخي والكونيّ للإيمان بالمسيح، فاعتادوا على تصوير الربّ على الجدار الشرقيّ في مجيئه الثاني كملكٍ – صورةً ترمُز للرجاء، أما على الجدار الغربيّ فاعتادوا تصوير الدينونة الأخيرة كرمزِ مسؤوليتنا عن حياتنا، فكانت هذه اللوحة تنظُرُ إلى المؤمنين وتُرافقهم في مسيرتهم نحو الحياة اليومية. لكن خلال تطوُّر فن الأيقونات نجد أن الجانب التهديديّ والترهيبيّ للدينونة قد طغى، وقد كانَ واضحاً أنه يُعجِبُ الرسّامين أكثر من ضياء الرجاء الذي غالباً ما أخفته تلك التهديدات.
42- في عصرنا الحاضر قد عفا الناسُ عن التفكيرِ في الدينونةِ الأخيرة: لقد تحوَّلَ الإيمانُ المسيحي إلى واقعٍ فرديّ يهدُفُ قبل كلِّ شيء إلى خلاص النفس الشخصيّ؛ أما التأمل حول تاريخ العالم فقد سيطرَ عليهِ فكرُ التطوُّر بشكلٍ كبير. لكن محتوى انتظار الدينونة الأخيرة الأساسيّ لم يختفِ، بل اتّخذَ شكلاً مختلفاً تماماً. بحسبِ جذوره وأهدافهِ يقومُ الإلحادَ في القرنين التاسع عشر والعشرين على مبدإٍ أخلاقيّ: فهو عبارة عن احتجاج ضدّ مظالم العالم والتاريخ. إنَّ عالماً كهذا بما فيه من مظالمٍ وآلامِ الأبرياء ووحشيّة السُلُطات، لا يُمكن أن يكونَ عملَ إلهٍ صالح. إن إلهاً مسؤولاً عن عالمٍ كهذا لن يكونَ إلهاً عادلاً ولا حتى صالحاً. فبإسم الأخلاق يجب معارضة هذا الإله. وبما أنه ليسَ من إلهٍ يحققُ العدلَ، يبدو الآن أن الإنسان نفسَه مدعوٌّ ليحققه. أمامَ آلامِ هذا العالم حتى وإنْ كنّا نتفهَّمُ إحتجاجاً ضدَّ الله كهذا الإحتجاج، يبقى الإدعاءُ بأنَّ قدرةَ الجماعةِ البشريةِ وواجبها في أن تعمل ما لا يعمله أيُّ إلهٍ ولا يستطيعُ عملُهُ، إدعاءً متغطرساً وبعيداً في جوهره عن الحقيقة. إن أعظَمَ الأعمالِ الوحشيةِ والمَظالمِ التي نتجتْ عن هذه الفرضية ليستْ مجرَّدَ صدفة، بل هي مؤَسَّسةٌ على الزيفِ الجوهريِّ لهذا الإدعاءِ. إن عالماً يريدُ أنْ يُحقِّقَ العدلَ بنفسِهِ هو عالمٌ بدونِ رجاء. لا أحد ولا شيء يُمكنه أن يُعوِّضَ عن آلام الماضي. لا أحد ولا شيء يمكنه أن يضمنَ بأن ضراوةَ السُلطات – مهما يكن قناعها الإيدولوجي المغري – لن تستمرَّ في التجبُّرِ على العالم. هكذا انتقدَ كبار مفكري مدرسة فرانكفورت ماكس هورخايمر وتيودور ف. أدورنو الإلحادَ كنقدهم للتأليه الوحائيّ [ط]. لقد نفى هورخايمر جذرياً إمكانيةَ وجود أي بديلٍ لله في العالم، لكنه رفضَ أيضاً صورة الله الصالحِ والعادل. وفي موقفه المتطرِّف مِن تحريم العهد القديم للصوَر، تحدّثَ عن «الحنين للإله المختلف جذرياً» ذاك الذي يبقى غريباً – كانت هذه صرخةُ رغبةٍ موجَّهةٍ لتاريخ البشرية. أدورنو أيضاً كان موافقاً بحزمٍ على التخلّي عن أيةِ صورةٍ لله، لدرجةِ أنهُ نفى أيضاً «صورةَ» الإلهِ المُحب. لكنه كان يؤكّد دائماً هذه الجدليّة «السلبية» ويجزُمُ بأن العدلَ، أي العدلَ الحقيقيّ لا يتطلَّبُ «عالماً يُلغى فيه ألمُ الزمنِ الحاضر فحسب، بل أن يُسترجَع الماضي ليخضعَ للحُكمِ كلُّ ما لا يمكن استرجاعه» [30]. وبتعبيرٍ إيجابيٍّ – يرفضه أدورنو – هذا يعني أن العدلَ لا يُمكنُ أن يتحقّقَ دونَ قيامةِ الأموات. إنَّ أملاً كهذا يؤدي إلى «قيامة الجسد، وهو أمرٌ غريبٌ تماماً عن المثالية وعن ملكوت الروح المُطلَق» [31].
43- يستطيعُ المسيحي لا بل عليهِ أن يتعلَّمَ دائماً مِن أمرِ التخلّي الكامل عن أي صورة، الوارد في وصية الله الأولى (راجع خر 20 / 4). لقد أكّد المجمع اللاتيراني الرابع أهميةَ حقيقةِ اللاهوتِ السلبيّ، فقد صرَّحَ بوضوحٍ أنه مهما كانَ الشبهُ بين الخالقِ والمخلوقِ كبيرٌ فإنَّ الإختلافَ بينهما هو دائماً أكبر [32]. مع ذلك، فلا يمكنُ للمؤمِن بدعوى التخلّي عن أيةِ صورةٍ أن يكتفيَ برفضِ نظريتيّ التأليه الوحائيّ والإلحاد، كما اعتقد كلٌّ مِن هورخايمِر وأدورنو. فالله نفسه في المسيح الذي صارَ إنساناً قد أعطانا «صورةً» لذاته. ففي المسيحِ المصلوب قد أُلغيَت بقوةٍ جميعُ الصوَرِ الخاطئةِ عن الله. الآن يكشِفُ اللهُ وجهَهُ في هيئةِ المُتألِّمِ الذي يَتقاسَمُ حالةَ الإنسانَ المتروكَ مِن اللهِ، آخذاً إياها على عاتقه. لقد صارَ هذا المتألِّمُ البريء رجاءً وضماناً: الله موجودٌ، وهوَ يعرفُ كيفَ يُحقِّقُ العدلَ بطريقةٍ لا نقدرُ أن نتخيَّلها، ولكننا نستطيعُ أن نتوقَّعها بالإيمان. نعم، هناكَ قيامةُ الجسد [33]. هناكَ عدلٌ [34]. هناكَ «استرجاعٌ» للألمِ الذي مضى، وتعويضٌ يُعيدُ لكلِّ ذي حقٍّ حقَّه. لذلك فإن الإيمانَ بالدينونةِ الأخيرة هي قبل كلِّ شيءٍ رجاءٌ – إنه ذلك الرجاء الذي بَدَتْ ضرورتهُ جليةً في ثوراتِ القرونِ الأخيرةِ. أنا مقتنعٌ بأن مسألةَ العدلِ هي الحجّةُ الجوهرية، وفي أي الأحوال هي الحجّةُ الأقوى في صالحِ الإيمانِ بالحياةِ الأبدية. طبعاً إن مجرَّدَ الحاجةِ الفرديةِ لرغبةٍ في الخلودِ وفي المحبةِ التي ننتظرُ، والتي لم ننلها في هذه الحياة تشكِّلُ بحدِّ ذاتها دافعاً مهماً للإيمانِ بأن الإنسانَ قد صُنع للخلود؛ لكن فقط إذا ما ربطنا هذه الحاجة بفكرة أنه لا يمكن لظُلمِ التاريخِ في النهايةِ أن ينتصرَ، تصبحُ ضرورةَ عودةِ المسيح والحياة الجديدةِ مقنِعةً بالكامل
44- إن الإحتجاجَ على الله بإسمِ العدلِ لا يُفيدُ شيئاً. فالعالمُ بدون الله هو عالمٌ بدونِ رجاء (راجع أف 2 / 12). وحدهُ الله قادرٌ على إحقاقِ العدل والإيمانُ يمنحنا الضمانَ بأنه يفعل ذلك. إن صورةَ الدينونةِ الأخيرة هي قبل كل شيءٍ ليست صورةَ ترهيبٍ، بل صورةَ رجاءٍ؛ لا بل هي بالنسبة لنا على الأغلبِ صورةَ الرجاءِ الحاسم. لكن أليسَتْ أيضاً صورةً مخيفة؟ أنا أقول بأنها صورةٌ تستدعي المسؤولية. هي إذاً صورةُ ذلكَ الخوف الذي يقولُ عنه القديس هيلاريوس بأن كل خوفنا ينبع من المحبة [35]. الله عدلٌ وهو يُحقّقُ العدلَ. هذا هو عزاؤنا ورجاؤنا. لكنه في عدلِهِ هو أيضاً نعمة. نحنُ نعرفُ هذا إذا ما نظرنا إلى المسيحِ المصلوبِ والقائم. علينا أن نرى العدلَ والنعمةَ في علاقتهما الجوهرية. النعمة لا تُلغي العدلَ. لا تجعلُ الخطأ صواباً. هي ليستْ بممحاةٍ تمسحُ كل شيءٍ بحيثُ أن كلَّ ما حدثَ على وجهِ الأرضِ يُعتَبَرُ ذا قيمةٍ متساوية. لقد احتجَّ بحقٍ ضدَّ هذا الشكل من السماء والنعمة دوستويفسكي في روايته «الإخوة كارمازوف». في النهاية، في الوليمة الأبدية، لن يجلِسَ الأشرارُ على المائدةِ جانبَ ضحاياهم كما لو أن شيئاً لمْ يحصل. أودُّ هنا أن أستشهدَ بنصٍّ لأفلاطون فيه يُعبِّرُ عن إحساسه بالدينونة العادلة، وهو نصٌّ يبقى في جزئه الأكبر حقيقياً ومفيداً للمسيحيّ أيضاً. هو يستعملُ صوراً أسطورية، إلا أنه يعبِّرُ بوضوحٍ ليس فيه أي إلتباس عن الحقيقة، فيقولُ بأن النفوسَ في النهاية ستقفُ عاريةً أمامَ الديّان. عندئذٍ لا يهمّ من كانوا في تاريخهم الماضي، بل المهمُّ هو فقط حقيقتهم. وقتئذٍ «تقف في محضر الديّانِ نفسُ [...] ملكٍ أو والٍ فلا يرى فيها أي شيءٍ صالحٍ، بل يراها مضروبةً مملوءةً بالقروحِ بسببِ الحنث والظلمِ [...] كل ما فيها مشوهٌ ومليءٌ بالزيف والكبرياء، لا شيء فيها مستقيم لأنها كَبرتْ بدون حقيقة. وهو يرى كيف أن النفسَ موسومةً بالوحشيةِ والذُلِّ بسببِ مزاجيَّتها وعنفها وتهورها وعدم تقدير أفعالها. أمامَ هذا المشهد يُرسلها فوراً إلى السجنِ، حيثُ عليها أن تتحمَّلَ العقوبات المستحَقّة [...] لكنه أحياناً يجدُ أمامهُ نفساً مختلفةً، قد عاشتْ حياةً تقيّةً وصادقة [...]، فيُسرُّ بها ويرسلُها بالتأكيدِ إلى جُزُرِ الطوبايين» [36]. بهدفِ تحذيرنا قدَّمَ لنا يسوعُ في مَثلِ الغني النهم والفقير لعازر (راجع لو 16 / 19 - 31) صورةً لنفسٍ هالكةٍ بسببِ غرورها وغِناها، لقد حَفَرت هي نفسها وادياً عميقاً بينها وبين الفقير: واديَ الإنغلاق في حدودِ اللذات الماديّة، واديَ نسيانِ الآخر وعدم قدرتها على المحبة، فتحوَّلَ إلى عطشٍ حارقٍ لم يَعد بالإمكانِ شفاؤه بعد الآن. علينا أن نوضح هنا أن يسوعَ لا يتحدَّثُ في هذا المثلِ عن المصير النهائيّ بعدَ الدينونةِ الشاملة، بل يتخذُ فكرةً كانت سائدةً كغيرها في الديانة اليهودية القديمة، والقائلةِ بوجودِ حالةٍ مؤقتةٍ بينَ الموتِ والقيامةِ، حالةٍ لم يُنطَق فيها الحكمَ النهائي بَعد.
45- لا تَعتَبرُ هذه الفكرةُ الخاصةُ بالديانة اليهودية القديمة القائلةُ بوجودِ حالةٍ مؤقتة أنَّ النفوسَ توجدُ تحتَ الحراسةِ المؤقتة فقط، بل أنها تُعاقَبُ أيضاً، كما نرى في مثل الغني النهِم، أو أنها تتمتّعُ بشكلٍ من أشكالِ السعادةِ إلى حين. وفي النهاية لم تكن تغيبُ تماماً إمكانيةُ وجودِ تطهيرٍ وشفاءٍ يجعلُ النفسَ تنضجُ في سبيلِ الشركةِ مع الله. وقد اتَّخذَتْ الكنيسة الأولى هذه الأفكار التي تطوَّرتْ منها فيما بعد في الكنيسة الغربية عقيدة المطهر. لسنا بحاجة هنا لنفحصَ طرق هذا التطور التاريخية المُعقَّدة؛ لنسأل أنفسنا بالأحرى ما معناهُ الحقيقيّ. بالموت يصبحُ خيارُ الحياةِ الذي اتخذه الإنسانُ حاسماً وتغدو حياته هذه أمامَ الديّان. ويتّخذُ خيارُه الذي تُرجِمَ في سيرةِ الحياةِ أشكالاً متعددة. هناكَ أشخاصٌ قد هدموا نهائياً في ذواتهم الرغبةَ في الحقيقةِ والجاهزيةَ للمحبة. أشخاصٌ كل ما فيهم قد صارَ مزيّفاً؛ أشخاصٌ قد عاشوا في سبيلِ الكراهيةِ فداسوا في ذواتهم المحبة. هذه صورةٌ رهيبةٌ، لكن بعض شخصيات تاريخنا تجعلنا نرى فيها بصورةٍ مرعبةٍ هذه الهيئة. في أفرادٍ كهؤلاءِ لم يعدْ هناكَ شيءٌ يمكنُ استرجاعه فهلاكُ الخيرِ فيهم نهائيّ: هذا ما نقصده بكلمة جهنم [37]. من ناحيةٍ أخرى هناكَ أشخاصٌ شديدي النقاوة، قد سمحوا لله أن يدخل فيهم بشكلٍ كاملٍ وبالنتيجةِ هم منفتحون تماماً على الآخرين – هم أشخاصٌ قد وجَّهَتْ منذُ الآنَ الشركةُ مع اللهِ كيانَهم بالكامل، ورحيلهم نحو الله ما هو إلا إتمامٌ لما هم عليه منذُ الآن [38].
46- حسب خبرتنا لا تمثِّلُ الحالةُ الأولى ولا الثانية الوضعَ الطبيعيَّ للوجودِ الإنسانيّ. أكثرُ الناس – هذا ما نعتقده – يبقى حاضراً في أعماقِ جوهرهم انفتاحٌ أخيرٌ داخليٌّ على الحقيقةِ والمحبةِ والله. لكنه انفتاحٌ تغطّيه في خيارات الحياة تنازلاتٌ نحو الشرِّ تتجدَّدُ دائماً. فتتخفّى الطهارةُ تحتَ القذارةِ الكثيرة، لكن مع ذلك يبقى العطشُ لها موجوداً ويعودُ فيظهرُ من جديد، بالرغم من كل شيء، مِن الأسافلِ ليبقى حاضراً في النفس. ما الذي يحصل لهؤلاء عندما يظهرونَ أمامَ الديّان؟ كل الأشياء القذرة التي كوَّموها طوال حياتهم أتصبحُ فجأةً دون أهمية؟ أو ما الذي يمكن أن يحصل لها؟ يعطينا القديس بولس في الرسالة الأولى إلى كورنثوس فكرةً عن تأثيرِ حُكمِ اللهِ المختلفِ على الإنسانِ حسبَ حالته. وهو يفعلُ ذلكَ عن طريق صورٍ يريدُ بها أن يُعبِّرَ عن اللامرئيّ، ونحنُ لا نستطيعُ أن نحوِّلَ هذه الصور إلى أفكارٍ، وذلك لأننا ببساطة لا نستطيعُ أن ننظرَ إلى عالمِ ما بعدَ الموت وليستْ لدينا أيّةُ خبرةٍ له. يصفُ بولس الحياةَ المسيحيةَ بأنها – قبل كل شيء – مبنيةٌ على أساسٍ مشترك: يسوع المسيح. هذا الأساسُ لا يزول. إذا ما بقينا ثابتينَ في هذا الأساسِ وبنينا عليه حياتَنا، نعرفُ أنهُ أساسٌ لا يمكنُ لأحدٍ أن يسلبه منّا ولا حتى عند الموت. ثم يتابعُ بولس قائلاً: «و لكن إن كان أحدٌ يبني على هذا الأساسِ ذهباً، فضةً، حجارةً كريمةً، خشباً، عشباً، قشاً، فعملُ كلِّ واحدٍ سيصيرُ ظاهراً لأنَّ ذلكَ اليومَ سيبيِّنه، لأنّهُ بنارٍ يستعلِنُ وستَمتحنُ النارُ عملَ كلِّ واحدٍ ما هو، فإن بقيَ عملُ أحدٍ قد بناهُ عليه فسيأخُذُ أجرةً، وإن احترقَ عملُ أحدٍ فسيخسَرُ وأمّا هو فسيخلُصُ ولكن كما بنارٍ» (1 كو 3 / 12 - 15). من الواضحِ في هذا النصّ أن خلاصَ البشرِ سيتّخذُ أشكالاً مختلفة؛ أن بعضَ الأشياءِ المبنيةِ يمكنها أن تحترقَ نهائياً؛ وأنه لأجلِ الخلاص على كلِّ واحدٍ أن يَعبرَ «النار» كي يصبحَ قابلاً للهِ بشكلٍ نهائيّ، ويستطيعَ أن يجلسَ إلى مائدةِ العرس الأبدية.
41- يتحدَّث قانون إيمان الكنيسة في جزئه المحوري عن سرّ المسيح منذ ولادته الأزلية من الآب إلى ولادته الزمنية من العذراء مريم ليَصلَ مروراً بالصليب إلى القيامة حتى عودته، ويختم بالعبارة: «... سيأتي من جديد ليدين الأحياءَ والأموات». لقد أثَّرت فكرة الدينونة الأخيرة، منذ الأزمنة الأولى، على المسيحيين حتى في حياتهم اليومية، فكانت لهم بمثابةِ مقياسٍ لتنظيم حياتهم الحاضرة، ونداءٍ لإتباعِ الضمير وفي نفس الوقت كانت لهم رجاءً في عدل الله. إنَّ الإيمانَ بالمسيح لَمْ ينظر أبداً إلى الوراء فحَسْب، ولا إلى العَلاء فحَسْب، بل هو ينظرُ على الدوام إلى الأمامِ أيضاً، إلى ساعةِ العدلِ التي كان الربُّ قد سبقَ وأعلنها مراراً. هذه النظرة إلى الأمام قد أضفَتْ على المسيحيةِ أهميتها الخاصة بالنسبة للحاضر. أرادَ المسيحيون عن طريق تنسيقِ دور العبادة، أن يُظهِروا البُعد التاريخي والكونيّ للإيمان بالمسيح، فاعتادوا على تصوير الربّ على الجدار الشرقيّ في مجيئه الثاني كملكٍ – صورةً ترمُز للرجاء، أما على الجدار الغربيّ فاعتادوا تصوير الدينونة الأخيرة كرمزِ مسؤوليتنا عن حياتنا، فكانت هذه اللوحة تنظُرُ إلى المؤمنين وتُرافقهم في مسيرتهم نحو الحياة اليومية. لكن خلال تطوُّر فن الأيقونات نجد أن الجانب التهديديّ والترهيبيّ للدينونة قد طغى، وقد كانَ واضحاً أنه يُعجِبُ الرسّامين أكثر من ضياء الرجاء الذي غالباً ما أخفته تلك التهديدات.
42- في عصرنا الحاضر قد عفا الناسُ عن التفكيرِ في الدينونةِ الأخيرة: لقد تحوَّلَ الإيمانُ المسيحي إلى واقعٍ فرديّ يهدُفُ قبل كلِّ شيء إلى خلاص النفس الشخصيّ؛ أما التأمل حول تاريخ العالم فقد سيطرَ عليهِ فكرُ التطوُّر بشكلٍ كبير. لكن محتوى انتظار الدينونة الأخيرة الأساسيّ لم يختفِ، بل اتّخذَ شكلاً مختلفاً تماماً. بحسبِ جذوره وأهدافهِ يقومُ الإلحادَ في القرنين التاسع عشر والعشرين على مبدإٍ أخلاقيّ: فهو عبارة عن احتجاج ضدّ مظالم العالم والتاريخ. إنَّ عالماً كهذا بما فيه من مظالمٍ وآلامِ الأبرياء ووحشيّة السُلُطات، لا يُمكن أن يكونَ عملَ إلهٍ صالح. إن إلهاً مسؤولاً عن عالمٍ كهذا لن يكونَ إلهاً عادلاً ولا حتى صالحاً. فبإسم الأخلاق يجب معارضة هذا الإله. وبما أنه ليسَ من إلهٍ يحققُ العدلَ، يبدو الآن أن الإنسان نفسَه مدعوٌّ ليحققه. أمامَ آلامِ هذا العالم حتى وإنْ كنّا نتفهَّمُ إحتجاجاً ضدَّ الله كهذا الإحتجاج، يبقى الإدعاءُ بأنَّ قدرةَ الجماعةِ البشريةِ وواجبها في أن تعمل ما لا يعمله أيُّ إلهٍ ولا يستطيعُ عملُهُ، إدعاءً متغطرساً وبعيداً في جوهره عن الحقيقة. إن أعظَمَ الأعمالِ الوحشيةِ والمَظالمِ التي نتجتْ عن هذه الفرضية ليستْ مجرَّدَ صدفة، بل هي مؤَسَّسةٌ على الزيفِ الجوهريِّ لهذا الإدعاءِ. إن عالماً يريدُ أنْ يُحقِّقَ العدلَ بنفسِهِ هو عالمٌ بدونِ رجاء. لا أحد ولا شيء يُمكنه أن يُعوِّضَ عن آلام الماضي. لا أحد ولا شيء يمكنه أن يضمنَ بأن ضراوةَ السُلطات – مهما يكن قناعها الإيدولوجي المغري – لن تستمرَّ في التجبُّرِ على العالم. هكذا انتقدَ كبار مفكري مدرسة فرانكفورت ماكس هورخايمر وتيودور ف. أدورنو الإلحادَ كنقدهم للتأليه الوحائيّ [ط]. لقد نفى هورخايمر جذرياً إمكانيةَ وجود أي بديلٍ لله في العالم، لكنه رفضَ أيضاً صورة الله الصالحِ والعادل. وفي موقفه المتطرِّف مِن تحريم العهد القديم للصوَر، تحدّثَ عن «الحنين للإله المختلف جذرياً» ذاك الذي يبقى غريباً – كانت هذه صرخةُ رغبةٍ موجَّهةٍ لتاريخ البشرية. أدورنو أيضاً كان موافقاً بحزمٍ على التخلّي عن أيةِ صورةٍ لله، لدرجةِ أنهُ نفى أيضاً «صورةَ» الإلهِ المُحب. لكنه كان يؤكّد دائماً هذه الجدليّة «السلبية» ويجزُمُ بأن العدلَ، أي العدلَ الحقيقيّ لا يتطلَّبُ «عالماً يُلغى فيه ألمُ الزمنِ الحاضر فحسب، بل أن يُسترجَع الماضي ليخضعَ للحُكمِ كلُّ ما لا يمكن استرجاعه» [30]. وبتعبيرٍ إيجابيٍّ – يرفضه أدورنو – هذا يعني أن العدلَ لا يُمكنُ أن يتحقّقَ دونَ قيامةِ الأموات. إنَّ أملاً كهذا يؤدي إلى «قيامة الجسد، وهو أمرٌ غريبٌ تماماً عن المثالية وعن ملكوت الروح المُطلَق» [31].
43- يستطيعُ المسيحي لا بل عليهِ أن يتعلَّمَ دائماً مِن أمرِ التخلّي الكامل عن أي صورة، الوارد في وصية الله الأولى (راجع خر 20 / 4). لقد أكّد المجمع اللاتيراني الرابع أهميةَ حقيقةِ اللاهوتِ السلبيّ، فقد صرَّحَ بوضوحٍ أنه مهما كانَ الشبهُ بين الخالقِ والمخلوقِ كبيرٌ فإنَّ الإختلافَ بينهما هو دائماً أكبر [32]. مع ذلك، فلا يمكنُ للمؤمِن بدعوى التخلّي عن أيةِ صورةٍ أن يكتفيَ برفضِ نظريتيّ التأليه الوحائيّ والإلحاد، كما اعتقد كلٌّ مِن هورخايمِر وأدورنو. فالله نفسه في المسيح الذي صارَ إنساناً قد أعطانا «صورةً» لذاته. ففي المسيحِ المصلوب قد أُلغيَت بقوةٍ جميعُ الصوَرِ الخاطئةِ عن الله. الآن يكشِفُ اللهُ وجهَهُ في هيئةِ المُتألِّمِ الذي يَتقاسَمُ حالةَ الإنسانَ المتروكَ مِن اللهِ، آخذاً إياها على عاتقه. لقد صارَ هذا المتألِّمُ البريء رجاءً وضماناً: الله موجودٌ، وهوَ يعرفُ كيفَ يُحقِّقُ العدلَ بطريقةٍ لا نقدرُ أن نتخيَّلها، ولكننا نستطيعُ أن نتوقَّعها بالإيمان. نعم، هناكَ قيامةُ الجسد [33]. هناكَ عدلٌ [34]. هناكَ «استرجاعٌ» للألمِ الذي مضى، وتعويضٌ يُعيدُ لكلِّ ذي حقٍّ حقَّه. لذلك فإن الإيمانَ بالدينونةِ الأخيرة هي قبل كلِّ شيءٍ رجاءٌ – إنه ذلك الرجاء الذي بَدَتْ ضرورتهُ جليةً في ثوراتِ القرونِ الأخيرةِ. أنا مقتنعٌ بأن مسألةَ العدلِ هي الحجّةُ الجوهرية، وفي أي الأحوال هي الحجّةُ الأقوى في صالحِ الإيمانِ بالحياةِ الأبدية. طبعاً إن مجرَّدَ الحاجةِ الفرديةِ لرغبةٍ في الخلودِ وفي المحبةِ التي ننتظرُ، والتي لم ننلها في هذه الحياة تشكِّلُ بحدِّ ذاتها دافعاً مهماً للإيمانِ بأن الإنسانَ قد صُنع للخلود؛ لكن فقط إذا ما ربطنا هذه الحاجة بفكرة أنه لا يمكن لظُلمِ التاريخِ في النهايةِ أن ينتصرَ، تصبحُ ضرورةَ عودةِ المسيح والحياة الجديدةِ مقنِعةً بالكامل
44- إن الإحتجاجَ على الله بإسمِ العدلِ لا يُفيدُ شيئاً. فالعالمُ بدون الله هو عالمٌ بدونِ رجاء (راجع أف 2 / 12). وحدهُ الله قادرٌ على إحقاقِ العدل والإيمانُ يمنحنا الضمانَ بأنه يفعل ذلك. إن صورةَ الدينونةِ الأخيرة هي قبل كل شيءٍ ليست صورةَ ترهيبٍ، بل صورةَ رجاءٍ؛ لا بل هي بالنسبة لنا على الأغلبِ صورةَ الرجاءِ الحاسم. لكن أليسَتْ أيضاً صورةً مخيفة؟ أنا أقول بأنها صورةٌ تستدعي المسؤولية. هي إذاً صورةُ ذلكَ الخوف الذي يقولُ عنه القديس هيلاريوس بأن كل خوفنا ينبع من المحبة [35]. الله عدلٌ وهو يُحقّقُ العدلَ. هذا هو عزاؤنا ورجاؤنا. لكنه في عدلِهِ هو أيضاً نعمة. نحنُ نعرفُ هذا إذا ما نظرنا إلى المسيحِ المصلوبِ والقائم. علينا أن نرى العدلَ والنعمةَ في علاقتهما الجوهرية. النعمة لا تُلغي العدلَ. لا تجعلُ الخطأ صواباً. هي ليستْ بممحاةٍ تمسحُ كل شيءٍ بحيثُ أن كلَّ ما حدثَ على وجهِ الأرضِ يُعتَبَرُ ذا قيمةٍ متساوية. لقد احتجَّ بحقٍ ضدَّ هذا الشكل من السماء والنعمة دوستويفسكي في روايته «الإخوة كارمازوف». في النهاية، في الوليمة الأبدية، لن يجلِسَ الأشرارُ على المائدةِ جانبَ ضحاياهم كما لو أن شيئاً لمْ يحصل. أودُّ هنا أن أستشهدَ بنصٍّ لأفلاطون فيه يُعبِّرُ عن إحساسه بالدينونة العادلة، وهو نصٌّ يبقى في جزئه الأكبر حقيقياً ومفيداً للمسيحيّ أيضاً. هو يستعملُ صوراً أسطورية، إلا أنه يعبِّرُ بوضوحٍ ليس فيه أي إلتباس عن الحقيقة، فيقولُ بأن النفوسَ في النهاية ستقفُ عاريةً أمامَ الديّان. عندئذٍ لا يهمّ من كانوا في تاريخهم الماضي، بل المهمُّ هو فقط حقيقتهم. وقتئذٍ «تقف في محضر الديّانِ نفسُ [...] ملكٍ أو والٍ فلا يرى فيها أي شيءٍ صالحٍ، بل يراها مضروبةً مملوءةً بالقروحِ بسببِ الحنث والظلمِ [...] كل ما فيها مشوهٌ ومليءٌ بالزيف والكبرياء، لا شيء فيها مستقيم لأنها كَبرتْ بدون حقيقة. وهو يرى كيف أن النفسَ موسومةً بالوحشيةِ والذُلِّ بسببِ مزاجيَّتها وعنفها وتهورها وعدم تقدير أفعالها. أمامَ هذا المشهد يُرسلها فوراً إلى السجنِ، حيثُ عليها أن تتحمَّلَ العقوبات المستحَقّة [...] لكنه أحياناً يجدُ أمامهُ نفساً مختلفةً، قد عاشتْ حياةً تقيّةً وصادقة [...]، فيُسرُّ بها ويرسلُها بالتأكيدِ إلى جُزُرِ الطوبايين» [36]. بهدفِ تحذيرنا قدَّمَ لنا يسوعُ في مَثلِ الغني النهم والفقير لعازر (راجع لو 16 / 19 - 31) صورةً لنفسٍ هالكةٍ بسببِ غرورها وغِناها، لقد حَفَرت هي نفسها وادياً عميقاً بينها وبين الفقير: واديَ الإنغلاق في حدودِ اللذات الماديّة، واديَ نسيانِ الآخر وعدم قدرتها على المحبة، فتحوَّلَ إلى عطشٍ حارقٍ لم يَعد بالإمكانِ شفاؤه بعد الآن. علينا أن نوضح هنا أن يسوعَ لا يتحدَّثُ في هذا المثلِ عن المصير النهائيّ بعدَ الدينونةِ الشاملة، بل يتخذُ فكرةً كانت سائدةً كغيرها في الديانة اليهودية القديمة، والقائلةِ بوجودِ حالةٍ مؤقتةٍ بينَ الموتِ والقيامةِ، حالةٍ لم يُنطَق فيها الحكمَ النهائي بَعد.
45- لا تَعتَبرُ هذه الفكرةُ الخاصةُ بالديانة اليهودية القديمة القائلةُ بوجودِ حالةٍ مؤقتة أنَّ النفوسَ توجدُ تحتَ الحراسةِ المؤقتة فقط، بل أنها تُعاقَبُ أيضاً، كما نرى في مثل الغني النهِم، أو أنها تتمتّعُ بشكلٍ من أشكالِ السعادةِ إلى حين. وفي النهاية لم تكن تغيبُ تماماً إمكانيةُ وجودِ تطهيرٍ وشفاءٍ يجعلُ النفسَ تنضجُ في سبيلِ الشركةِ مع الله. وقد اتَّخذَتْ الكنيسة الأولى هذه الأفكار التي تطوَّرتْ منها فيما بعد في الكنيسة الغربية عقيدة المطهر. لسنا بحاجة هنا لنفحصَ طرق هذا التطور التاريخية المُعقَّدة؛ لنسأل أنفسنا بالأحرى ما معناهُ الحقيقيّ. بالموت يصبحُ خيارُ الحياةِ الذي اتخذه الإنسانُ حاسماً وتغدو حياته هذه أمامَ الديّان. ويتّخذُ خيارُه الذي تُرجِمَ في سيرةِ الحياةِ أشكالاً متعددة. هناكَ أشخاصٌ قد هدموا نهائياً في ذواتهم الرغبةَ في الحقيقةِ والجاهزيةَ للمحبة. أشخاصٌ كل ما فيهم قد صارَ مزيّفاً؛ أشخاصٌ قد عاشوا في سبيلِ الكراهيةِ فداسوا في ذواتهم المحبة. هذه صورةٌ رهيبةٌ، لكن بعض شخصيات تاريخنا تجعلنا نرى فيها بصورةٍ مرعبةٍ هذه الهيئة. في أفرادٍ كهؤلاءِ لم يعدْ هناكَ شيءٌ يمكنُ استرجاعه فهلاكُ الخيرِ فيهم نهائيّ: هذا ما نقصده بكلمة جهنم [37]. من ناحيةٍ أخرى هناكَ أشخاصٌ شديدي النقاوة، قد سمحوا لله أن يدخل فيهم بشكلٍ كاملٍ وبالنتيجةِ هم منفتحون تماماً على الآخرين – هم أشخاصٌ قد وجَّهَتْ منذُ الآنَ الشركةُ مع اللهِ كيانَهم بالكامل، ورحيلهم نحو الله ما هو إلا إتمامٌ لما هم عليه منذُ الآن [38].
46- حسب خبرتنا لا تمثِّلُ الحالةُ الأولى ولا الثانية الوضعَ الطبيعيَّ للوجودِ الإنسانيّ. أكثرُ الناس – هذا ما نعتقده – يبقى حاضراً في أعماقِ جوهرهم انفتاحٌ أخيرٌ داخليٌّ على الحقيقةِ والمحبةِ والله. لكنه انفتاحٌ تغطّيه في خيارات الحياة تنازلاتٌ نحو الشرِّ تتجدَّدُ دائماً. فتتخفّى الطهارةُ تحتَ القذارةِ الكثيرة، لكن مع ذلك يبقى العطشُ لها موجوداً ويعودُ فيظهرُ من جديد، بالرغم من كل شيء، مِن الأسافلِ ليبقى حاضراً في النفس. ما الذي يحصل لهؤلاء عندما يظهرونَ أمامَ الديّان؟ كل الأشياء القذرة التي كوَّموها طوال حياتهم أتصبحُ فجأةً دون أهمية؟ أو ما الذي يمكن أن يحصل لها؟ يعطينا القديس بولس في الرسالة الأولى إلى كورنثوس فكرةً عن تأثيرِ حُكمِ اللهِ المختلفِ على الإنسانِ حسبَ حالته. وهو يفعلُ ذلكَ عن طريق صورٍ يريدُ بها أن يُعبِّرَ عن اللامرئيّ، ونحنُ لا نستطيعُ أن نحوِّلَ هذه الصور إلى أفكارٍ، وذلك لأننا ببساطة لا نستطيعُ أن ننظرَ إلى عالمِ ما بعدَ الموت وليستْ لدينا أيّةُ خبرةٍ له. يصفُ بولس الحياةَ المسيحيةَ بأنها – قبل كل شيء – مبنيةٌ على أساسٍ مشترك: يسوع المسيح. هذا الأساسُ لا يزول. إذا ما بقينا ثابتينَ في هذا الأساسِ وبنينا عليه حياتَنا، نعرفُ أنهُ أساسٌ لا يمكنُ لأحدٍ أن يسلبه منّا ولا حتى عند الموت. ثم يتابعُ بولس قائلاً: «و لكن إن كان أحدٌ يبني على هذا الأساسِ ذهباً، فضةً، حجارةً كريمةً، خشباً، عشباً، قشاً، فعملُ كلِّ واحدٍ سيصيرُ ظاهراً لأنَّ ذلكَ اليومَ سيبيِّنه، لأنّهُ بنارٍ يستعلِنُ وستَمتحنُ النارُ عملَ كلِّ واحدٍ ما هو، فإن بقيَ عملُ أحدٍ قد بناهُ عليه فسيأخُذُ أجرةً، وإن احترقَ عملُ أحدٍ فسيخسَرُ وأمّا هو فسيخلُصُ ولكن كما بنارٍ» (1 كو 3 / 12 - 15). من الواضحِ في هذا النصّ أن خلاصَ البشرِ سيتّخذُ أشكالاً مختلفة؛ أن بعضَ الأشياءِ المبنيةِ يمكنها أن تحترقَ نهائياً؛ وأنه لأجلِ الخلاص على كلِّ واحدٍ أن يَعبرَ «النار» كي يصبحَ قابلاً للهِ بشكلٍ نهائيّ، ويستطيعَ أن يجلسَ إلى مائدةِ العرس الأبدية.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى