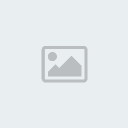مايكل عادلعضو نشيط
مايكل عادلعضو نشيط
 الرسالة العامة (بالرجاء مخلصون) 11 البابا بندكتس
الرسالة العامة (بالرجاء مخلصون) 11 البابا بندكتس
الأربعاء مايو 14, 2008 4:12 pm
بالرجاء مخلصونSpe Salvi
47- يعتقدُ بعضُ اللاهوتيين الحديثين أن النارَ التي تحرق وتخلِّصُ في آنٍ واحدٍ هي المسيحُ بالذات، الديّانُ والمخلِّص. اللقاءُ به هو الدينونةُ الحاسمةُ. أمامَ عينيهِ يتلاشى كلُّ زيفٍ. فاللقاءُ به يحرقنا ويحوّلُنا ويحرّرنا لنصبح بالحقيقةِ ذواتَنا. فالأشياءُ المبنيّةُ خلالَ الحياةِ يمكنها أن تظهرَ كالقشِّ اليابسِ، وتتهدَّمُ كإفتخارٍ دون سبب. لكن في ألمِ هذا اللقاءِ الذي فيهِ يصبحُ رجسُ كياننا ومرضه واضحاً، يكمنُ خلاصُنا. نظرتُهُ ولمسةُ قلبِهِ تشفينا من خلالٍ تحوُّلٍ مؤلمٍ بكلِّ تأكيد «كما بنار». مع ذلك فهوَ ألمٌ طوباويٌّ، فيه تدخلُ فينا قوةُ محبتهِ القدوسة كشعلةٍ، فتجعلنا أخيراً أن نكونَ ذواتَنا بشكلٍ كاملٍ وبذلكَ نكونُ تماماً لله. هكذا يظهرُ أيضاً ترابطُ العدلِ والنعمةِ: فالطريقة التي نحيا بها ليست دون أهمية، لكن قذارتنا لا تسمنا إلى الأبد، أقلّه إن بقينا مشدودين نحو المسيح، نحو الحقيقةِ والمحبة. وفي الواقع لقد سبقَ وأُحرِقتْ هذه القذارة في آلام المسيح. سوف نختبرُ ونقتبلُ في لحظةِ الدينونة انتصارَ محبته على كلِّ الشرِّ في العالمِ وفينا. فيغدو ألمَ المحبةِ خلاصَنا وفرحَنا. من البديهي أننا لا نستطيعُ قياسَ «المدّةَ» التي فيها نختبرُ النارَ المُحوِّلةَ بمقاييسنا الزمنيّة في هذا العالم. لا يُمكنُ لقياسِ الزمَن الأرضيّ أن يحكمَ قبضته على «لحظةِ» ذاكَ اللقاءِ الذي سيُحوِّلنا – إنّه زَمَنُ القلب، زمَنُ «العبور» إلى الشركةِ مع الله في جسدِ المسيح [39]. إن دينونةَ الله هي رجاءٌ لأنها عدلٌ ونعمة. إن كانت مجرَّدَ نعمةٍ تُلغي قيمةَ كلَّ ما هو أرضيّ، يبقى اللهُ مديناً لنا بالجوابِ عن سؤالنا بشأنِ العدلِ – وهو يبقى سؤالاً حاسماً أمامَ التاريخِ وأمامَ الله. وإن كانت مجرّدَ عدلٍ لن تكون بالنسبةِ لنا إلا دافعاً للخوفِ. لقد ربطَ تجسُّدُ الله في المسيحِ الأمران معاً – العدلَ والنعمةَ – بشكلٍ يتحقّقُ فيه العدلُ بحزمٍ: فكلّنا نعمل لأجلِ خلاصنا «بخوفٍ ورعدةٍ» (فيل 2 / 12). مع ذلك تسمحُ النعمةُ لنا بأن نرجوَ وأن نسيرَ مملوئينَ ثقةً نحو الديّان الذي نعرفه كـ «محامينا» ومعزّينا (راجع 1 يو 2 / 1).
48- علينا أن نذكرَ هنا دافعاً آخرَ لأنهُ هامٌّ لممارسةِ الرجاء المسيحيّ. ففي الديانة اليهودية القديمة كانت توجدُ فكرةٌ تقولُ بأنه يمكنُ مساعدةَ الراقدينَ في حالتهم المؤقتة بواسطةِ الصلاة (راجع مثلاً 2 مكا 12 / 38 – 45: في القرن الأول قبل المسيح). لقد تبنَّى المسيحيونَ بعفوية بالغة هذه الممارسة التي أضحت مشتركةً بين كنيسة الشرقِ والغرب. وبينما لا يعترف الشرق بألمٍ مُطهّرٍ ومُكفِّرٍ للنفوسِ في الحياة الآتية، يعترفُ بدرجات متفاوتة من السعادة أو الألم في المرحلة المؤقتة. ويقولُ بأنه يمكننا أن نمنحَ النفوسَ «راحةً وانتعاشاً» من خلال الإفخارستيا والصلاة والصدقة. بأن المحبة يمكنها أن تصل إلى حيّزَ الأبديّة، ومن الممكنِ تبادلُ الخيراتِ فنبقى متحدين بعضنا البعضَ بروابطِ المَعَزَّةِ حتى بعدَ الموت – كانت هذه قناعةً أساسيةً في العالمِ المسيحيّ خلالَ العصورِ وتبقى اليومَ أيضاً خبرةً مُعزّية. مَن منّا لا يشعرُ بالحاجةِ لإيصالِ إشارةِ صلاحٍ وشكرٍ أو حتى طلبَ صفحٍ مِن أعزّائه الذين رحلوا إلى الأبدية؟ هنا يمكن أن يُطرحَ السؤال: إن كانَ «المَطهر» مجرَّدَ تطهيرٍ للإنسان من خلالِ لقائِهِ مع الرب، الديّانُ والمخلِّص، كيف يمكن لشخصٍ ثالثٍ أن يتدخَّلَ حتى لو كان قريباً جداً من المُتوفّى؟ عندما نطرحُ سؤالاً كهذا علينا أن نتذكر بأن ليس من إنسانٍ منغلقٍ على ذاته كجزيرةٍ معزولة. فوجودنا هو في شركة عميقة مع وجودِ الآخرين، وبفضلِ تفاعلاتٍ عديدةٍ يرتبطُ كلُّ واحدٍ بالآخر. لا أحد يحيا منعزلاً. لا أحد يرتكبُ الخطيئةَ منعزلاً. لا أحد ينالُ الخلاصَ منعزلاً. ففي حياتي تدخلُ بإستمرارٍ حياةَ الآخرين: في ما أفكّر، أقولُ، أعملُ، أحقّقُ. والعكسُ صحيح، فحياتي تدخلُ في حياةِ الآخرينَ: في الشر وفي الخير. هكذا لا تكون شفاعتي من أجل الآخر غريبةً عنه، كأمرٍ خارجيّ، ولا حتى بعدَ الموت. ففي ترابط الكيان، يمكنُ لشكري لهُ وصلاتي من أجلِهِ أن يشكلانِ مرحلةً صغيرةً من عمليةِ تطهيرِهِ. وبهذا ليس هناكَ حاجةٌ لتحويلِ الزمنِ الأرضيّ إلى زمن الله: فشَرِكةُ النفوسِ تتجاوزُ الزمنَ الأرضيّ المجرّد. فلا نعتقد أننا نتأخرُ أبداً في لمسِ قلبِ الآخر، ولن يكون هذا أبداً أمراً غير مجدي. هكذا يتوضحُ أكثر أحدُ العناصرِ الهامة لفكرة الرجاء المسيحي. فرجاؤنا هو دائماً في جوهره رجاءٌ لأجلِ الآخرين؛ هكذا فقط يكون رجاءً لي أنا أيضاً [40]. فنحنُ كمسيحيين يجب علينا ألا نسألَ أنفسنا فقط: كيف يمكنني أن أخلص؟ علينا أن نسألَ أنفسنا أيضاً: ماذا يمكنني أن أفعلَ كيما يخلُصَ آخرونَ وتشرقَ لهم نجمةُ الرجاء؟ عندها فقط سأكون قد عملتُ كل ما يجبُ عليّ عمله لخلاصي الشخصيّ.
مريم، نجمةُ الرجاء
49- تُحَيِّي الكنيسةُ مريمَ أمَّ الله بواسطةِ نشيدٍ يعود للقرن الثامن / التاسع، أي لأكثر من ألف سنةٍ، على أنها «نجمةُ البحر»: السلامُ عليكِ يا نجمةَ البحر (Ave maris stella) حياةُ الإنسانِ هي مسيرة. نحوَ أيةِ غايةٍ؟ كيف نجدُ الطريق؟ الحياةُ هي كسفرٍ في بحر التاريخ، غالباً ما يكونُ مظلماً وهائجاً، سفرةٌ نراقبُ فيها النجومَ التي ترشدنا الدربَ. النجومُ الحقيقيةُ لحياتنا همُ الأشخاصُ الذين عرفوا أن يحيوا بطريقة صحيحة. هم لنا أنوارُ الرجاء. طبعاً يسوع المسيح هو النورُ النموذجيّ، هو الشمسُ الساطعةُ في ظلامِ التاريخ. لكن كي نصلَ إليهِ نحنُ بحاجةٍ أيضاً لأنوارٍ قريبةٍ – لأشخاصٍ يشعّونَ نوراً متّخذينه من نوره، وهكذا يكونون لنا دليلاً في رحلتنا. وأيُّ شخصٍ يمكنه أن يكون لنا نجمةَ رجاءٍ أكثر من مريم – هي التي بقولها «نعم» قد فتحت للهِ باب عالمِنا؛ هي التي أضحَت تابوتَ العهدِ الحيّ، الذي صار الله فيهِ بشراً، صارَ واحداً منّا، نَصَبَ خيمتَهُ بيننا (راجع يو 1 / 14)؟
50- لها إذاً نتوجه قائلين: يا قديسة مريم، أنتِ كنتِ واحدةً من تلكَ النفوسِ المتواضعةِ والعظيمةِ في إسرائيلَ، تلكَ التي كسمعانَ كانت تنتظرُ «عزاءَ إسرائيل» (لو 2 / 25) وتتطلَّعُ كحنة إلى «فداءِ أورشليم» (لو 2 / 38). كنتِ تحيينَ بعلاقةٍ حميمةٍ مع كتبَ إسرائيلَ المقدسة، تلك التي كانت تتكلمُ عن الرجاء – عن وعدِ الله لإبراهيم ونسلِهِ (راجع لو 1 / 55). لهذا نفهمُ الرهبةَ المقدّسةَ التي شعرتِ بها عندما دخلَ ملاكُ الربِّ مخدعَكِ وقال لكِ بأنكِ ستلدين رجاءَ إسرائيلَ ومُنتَظَرَ العالم. بواسطتكِ وبفضلِ الـ «نَعَم» التي قلتيها، كان على الرجاء المنتَظَرِ منذُ آلافِ السنين أن يَغدوَ واقعاً، أن يدخُلَ في هذا العالم وفي تاريخه. لقد انحنيتِ أمامَ عظَمَةِ هذه المُهمّة وقلتِ «نَعَم»: «ها أنذا أمةُ الربِّ، ليكن لي بحسبِ قولكَ» (لو 1 / 38). وعندما كنتِ مملوءةً بالفرحِ وعَبَرتِ بسرعةٍ جبالَ اليهوديةِ لتصلي عندَ نسيبتِكِ أليصابات، قد صرتِ الكنيسةِ المستقبليّة التي تحملُ في داخلها رجاءَ العالمِ عَبرَ جبالِ التاريخ. مع الفرحِ الذي نشرتيهِ عَبرَ السنين من خلالِ ترديدنا وترتيلنا نشيدَكِ «تعظِّمُ نفسيّ الربَّ»، كنتِ على علمٍ أيضاً بأقوالِ الأنبياء الغامضة، التي تحدّثوا فيها عن ألَمِ عبدِ الله في هذا العالم. عند الميلادِ في مذود بيتِ لحم أشرَقَ ضياءُ الملائكةِ الذين حَمَلوا الخبرَ السارَّ للرعاة، لكن في نفس الوقت صار فقرُ الله في هذا العالم ملموساً إلى أقصى الحدود. لقد كلّمكِ الشيخُ سمعان عن السيفِ الذي كان سينفذُ في قلبك (راجع لو 2 / 35)، عن كون ابنكِ آيةً معرَّضةً للرفضِ في العالم. وعندما بدأ يسوعُ نشاطه العلنيّ كان عليكِ أن تتنحّي جانباً، في سبيل نموّ العائلة الجديدة التي أتى لأجلِ تأسيسها وهي تتطورُ بفضلِ مساهمةِ أولئكَ الذين سمعوا كلمته وحفظوها (راجع لو 11 / 27 وما يليه). وبالرغم من كل الفرح الذي رافقَ انطلاقةَ نشاطِ يسوع، كانَ عليكِ أن تختبري في مَجمَع الناصرة حقيقةَ «الآية المعرّضةِ للرفض» (راجع لو 4 / 28 وما يليه). هكذا قد رأيتِ سلطانَ الحقدِ المتزايدِ والرفضِ المتصاعِدِ تجاه يسوع حتى ساعةِ الصليب، حيث كان عليكِ أن تري مُخلِّصَ العالم، وريثَ داود، ابن الله يموت بين الأشرار، كفاشلٍ يسخرون منه. فقبلت عندئذٍ الكلمة: «يا امرأة، هذا ابنك!» (يو 19 / 26). ومن على الصليب أعطيتِ مُهمَّةً جديدة. فمن الصليب أصبحتِ أماً بطريقةٍ جديدة: أماً لكل الذين يريدون الإيمانَ بإبنكِ يسوع واتباعه. لقد نَفَذَ سيفُ الآلامِ قلبَكِ. فهل مات الرجاءُ؟ هل بقيَ العالمُ دونَ نورٍ نهائياً، وهل بقيتِ الحياةُ دون هدفٍ؟ في تلكَ الساعةِ قد سمعتِ، على الأغلب، في قلبكِ كلمةُ الملاكِ تتردَّدُ من جديد، تلك التي بها أجاب عن خوفكِ في لحظةِ البشارة: «لا تخافي، مريم!» (لو 1 / 30). كم مرةً كان قد ردّدها الربُّ ابنُك لتلاميذه: لا تخافوا! في ليلِ الجلجثة قد سمعتِ من جديدٍ هذه الكلمة. قبل ساعةِ تسلميه قد قال لتلاميذه: «ثقوا! فقد غلبتُ العالم» (يو 16 / 33). «لا تضطرب قلوبكم ولا تفزع» (يو 14 / 27). «لا تخافي، مريم!» يومَ البشارة قال لكِ الملاكُ أيضاً: «لن يكونَ لمُلكِهِ نهاية» (لو 1 / 33). فهل كان مُلْكُهُ قد انتهى قبل أن يبدأ؟ لا، عند الصليبِ، وحسبَ كلمة يسوعَ نفسها، أنتِ قد صرتِ أمَّ المؤمنين. بهذا الإيمان، الذي كانَ لكِ رجاءً أكيداً حتى في ظلامِ السبتِ المقدّس، قد سِرتِ نحوَ صباحِ الفصح. لقد لمسَ فرحُ القيامةِ قلبَكِ ووحَّدَكِ مع التلاميذِ بشكلٍ جديد، التلاميذ المزمعينَ أن يصيروا عائلةَ يسوع بفضلِ الإيمان. هكذا كنتِ موجودةً في وسط جماعةِ المؤمنين، الذين اجتمعوا ليُصلّوا بنفسٍ واحدةٍ بعد صعودِ الربِّ ليطلبوا عطيةَ الروح القدس (راجع أع 1 / 14) فنالوه في يوم العنصرة. لقد كان «ملكوت» يسوعَ مختلفاً عما تصّوره الناس. ذاك «الملكوت» الذي بدأ في تلك الساعة دون أن يكون له انقضاء. هكذا تظلّين أنتِ بين التلاميذِ كأمٍ لهم، كأمِّ الرجاء. يا قديسة مريم، يا والدةَ الله، علّمينا أن نؤمن، أن نرجو وأن نحبّ معكِ. أرشدينا الطريقَ نحوَ ملكوتِهِ! يا نجمةَ البحرِ، أشرقي علينا وسيري أمامَنا في الدرب!
أعطيَت في روما، قرب القديس بطرس
في 30 / تشرين الثاني
في عيد القديس أندراوس الرسول
عام 2007، الثالث لحبريّتنا
بندكتس السادس عشر
الحواشي:
39) المرجع السابق، الأعداد 1030 – 1032.
40) المرجع السابق، العدد 1032.
47- يعتقدُ بعضُ اللاهوتيين الحديثين أن النارَ التي تحرق وتخلِّصُ في آنٍ واحدٍ هي المسيحُ بالذات، الديّانُ والمخلِّص. اللقاءُ به هو الدينونةُ الحاسمةُ. أمامَ عينيهِ يتلاشى كلُّ زيفٍ. فاللقاءُ به يحرقنا ويحوّلُنا ويحرّرنا لنصبح بالحقيقةِ ذواتَنا. فالأشياءُ المبنيّةُ خلالَ الحياةِ يمكنها أن تظهرَ كالقشِّ اليابسِ، وتتهدَّمُ كإفتخارٍ دون سبب. لكن في ألمِ هذا اللقاءِ الذي فيهِ يصبحُ رجسُ كياننا ومرضه واضحاً، يكمنُ خلاصُنا. نظرتُهُ ولمسةُ قلبِهِ تشفينا من خلالٍ تحوُّلٍ مؤلمٍ بكلِّ تأكيد «كما بنار». مع ذلك فهوَ ألمٌ طوباويٌّ، فيه تدخلُ فينا قوةُ محبتهِ القدوسة كشعلةٍ، فتجعلنا أخيراً أن نكونَ ذواتَنا بشكلٍ كاملٍ وبذلكَ نكونُ تماماً لله. هكذا يظهرُ أيضاً ترابطُ العدلِ والنعمةِ: فالطريقة التي نحيا بها ليست دون أهمية، لكن قذارتنا لا تسمنا إلى الأبد، أقلّه إن بقينا مشدودين نحو المسيح، نحو الحقيقةِ والمحبة. وفي الواقع لقد سبقَ وأُحرِقتْ هذه القذارة في آلام المسيح. سوف نختبرُ ونقتبلُ في لحظةِ الدينونة انتصارَ محبته على كلِّ الشرِّ في العالمِ وفينا. فيغدو ألمَ المحبةِ خلاصَنا وفرحَنا. من البديهي أننا لا نستطيعُ قياسَ «المدّةَ» التي فيها نختبرُ النارَ المُحوِّلةَ بمقاييسنا الزمنيّة في هذا العالم. لا يُمكنُ لقياسِ الزمَن الأرضيّ أن يحكمَ قبضته على «لحظةِ» ذاكَ اللقاءِ الذي سيُحوِّلنا – إنّه زَمَنُ القلب، زمَنُ «العبور» إلى الشركةِ مع الله في جسدِ المسيح [39]. إن دينونةَ الله هي رجاءٌ لأنها عدلٌ ونعمة. إن كانت مجرَّدَ نعمةٍ تُلغي قيمةَ كلَّ ما هو أرضيّ، يبقى اللهُ مديناً لنا بالجوابِ عن سؤالنا بشأنِ العدلِ – وهو يبقى سؤالاً حاسماً أمامَ التاريخِ وأمامَ الله. وإن كانت مجرّدَ عدلٍ لن تكون بالنسبةِ لنا إلا دافعاً للخوفِ. لقد ربطَ تجسُّدُ الله في المسيحِ الأمران معاً – العدلَ والنعمةَ – بشكلٍ يتحقّقُ فيه العدلُ بحزمٍ: فكلّنا نعمل لأجلِ خلاصنا «بخوفٍ ورعدةٍ» (فيل 2 / 12). مع ذلك تسمحُ النعمةُ لنا بأن نرجوَ وأن نسيرَ مملوئينَ ثقةً نحو الديّان الذي نعرفه كـ «محامينا» ومعزّينا (راجع 1 يو 2 / 1).
48- علينا أن نذكرَ هنا دافعاً آخرَ لأنهُ هامٌّ لممارسةِ الرجاء المسيحيّ. ففي الديانة اليهودية القديمة كانت توجدُ فكرةٌ تقولُ بأنه يمكنُ مساعدةَ الراقدينَ في حالتهم المؤقتة بواسطةِ الصلاة (راجع مثلاً 2 مكا 12 / 38 – 45: في القرن الأول قبل المسيح). لقد تبنَّى المسيحيونَ بعفوية بالغة هذه الممارسة التي أضحت مشتركةً بين كنيسة الشرقِ والغرب. وبينما لا يعترف الشرق بألمٍ مُطهّرٍ ومُكفِّرٍ للنفوسِ في الحياة الآتية، يعترفُ بدرجات متفاوتة من السعادة أو الألم في المرحلة المؤقتة. ويقولُ بأنه يمكننا أن نمنحَ النفوسَ «راحةً وانتعاشاً» من خلال الإفخارستيا والصلاة والصدقة. بأن المحبة يمكنها أن تصل إلى حيّزَ الأبديّة، ومن الممكنِ تبادلُ الخيراتِ فنبقى متحدين بعضنا البعضَ بروابطِ المَعَزَّةِ حتى بعدَ الموت – كانت هذه قناعةً أساسيةً في العالمِ المسيحيّ خلالَ العصورِ وتبقى اليومَ أيضاً خبرةً مُعزّية. مَن منّا لا يشعرُ بالحاجةِ لإيصالِ إشارةِ صلاحٍ وشكرٍ أو حتى طلبَ صفحٍ مِن أعزّائه الذين رحلوا إلى الأبدية؟ هنا يمكن أن يُطرحَ السؤال: إن كانَ «المَطهر» مجرَّدَ تطهيرٍ للإنسان من خلالِ لقائِهِ مع الرب، الديّانُ والمخلِّص، كيف يمكن لشخصٍ ثالثٍ أن يتدخَّلَ حتى لو كان قريباً جداً من المُتوفّى؟ عندما نطرحُ سؤالاً كهذا علينا أن نتذكر بأن ليس من إنسانٍ منغلقٍ على ذاته كجزيرةٍ معزولة. فوجودنا هو في شركة عميقة مع وجودِ الآخرين، وبفضلِ تفاعلاتٍ عديدةٍ يرتبطُ كلُّ واحدٍ بالآخر. لا أحد يحيا منعزلاً. لا أحد يرتكبُ الخطيئةَ منعزلاً. لا أحد ينالُ الخلاصَ منعزلاً. ففي حياتي تدخلُ بإستمرارٍ حياةَ الآخرين: في ما أفكّر، أقولُ، أعملُ، أحقّقُ. والعكسُ صحيح، فحياتي تدخلُ في حياةِ الآخرينَ: في الشر وفي الخير. هكذا لا تكون شفاعتي من أجل الآخر غريبةً عنه، كأمرٍ خارجيّ، ولا حتى بعدَ الموت. ففي ترابط الكيان، يمكنُ لشكري لهُ وصلاتي من أجلِهِ أن يشكلانِ مرحلةً صغيرةً من عمليةِ تطهيرِهِ. وبهذا ليس هناكَ حاجةٌ لتحويلِ الزمنِ الأرضيّ إلى زمن الله: فشَرِكةُ النفوسِ تتجاوزُ الزمنَ الأرضيّ المجرّد. فلا نعتقد أننا نتأخرُ أبداً في لمسِ قلبِ الآخر، ولن يكون هذا أبداً أمراً غير مجدي. هكذا يتوضحُ أكثر أحدُ العناصرِ الهامة لفكرة الرجاء المسيحي. فرجاؤنا هو دائماً في جوهره رجاءٌ لأجلِ الآخرين؛ هكذا فقط يكون رجاءً لي أنا أيضاً [40]. فنحنُ كمسيحيين يجب علينا ألا نسألَ أنفسنا فقط: كيف يمكنني أن أخلص؟ علينا أن نسألَ أنفسنا أيضاً: ماذا يمكنني أن أفعلَ كيما يخلُصَ آخرونَ وتشرقَ لهم نجمةُ الرجاء؟ عندها فقط سأكون قد عملتُ كل ما يجبُ عليّ عمله لخلاصي الشخصيّ.
مريم، نجمةُ الرجاء
49- تُحَيِّي الكنيسةُ مريمَ أمَّ الله بواسطةِ نشيدٍ يعود للقرن الثامن / التاسع، أي لأكثر من ألف سنةٍ، على أنها «نجمةُ البحر»: السلامُ عليكِ يا نجمةَ البحر (Ave maris stella) حياةُ الإنسانِ هي مسيرة. نحوَ أيةِ غايةٍ؟ كيف نجدُ الطريق؟ الحياةُ هي كسفرٍ في بحر التاريخ، غالباً ما يكونُ مظلماً وهائجاً، سفرةٌ نراقبُ فيها النجومَ التي ترشدنا الدربَ. النجومُ الحقيقيةُ لحياتنا همُ الأشخاصُ الذين عرفوا أن يحيوا بطريقة صحيحة. هم لنا أنوارُ الرجاء. طبعاً يسوع المسيح هو النورُ النموذجيّ، هو الشمسُ الساطعةُ في ظلامِ التاريخ. لكن كي نصلَ إليهِ نحنُ بحاجةٍ أيضاً لأنوارٍ قريبةٍ – لأشخاصٍ يشعّونَ نوراً متّخذينه من نوره، وهكذا يكونون لنا دليلاً في رحلتنا. وأيُّ شخصٍ يمكنه أن يكون لنا نجمةَ رجاءٍ أكثر من مريم – هي التي بقولها «نعم» قد فتحت للهِ باب عالمِنا؛ هي التي أضحَت تابوتَ العهدِ الحيّ، الذي صار الله فيهِ بشراً، صارَ واحداً منّا، نَصَبَ خيمتَهُ بيننا (راجع يو 1 / 14)؟
50- لها إذاً نتوجه قائلين: يا قديسة مريم، أنتِ كنتِ واحدةً من تلكَ النفوسِ المتواضعةِ والعظيمةِ في إسرائيلَ، تلكَ التي كسمعانَ كانت تنتظرُ «عزاءَ إسرائيل» (لو 2 / 25) وتتطلَّعُ كحنة إلى «فداءِ أورشليم» (لو 2 / 38). كنتِ تحيينَ بعلاقةٍ حميمةٍ مع كتبَ إسرائيلَ المقدسة، تلك التي كانت تتكلمُ عن الرجاء – عن وعدِ الله لإبراهيم ونسلِهِ (راجع لو 1 / 55). لهذا نفهمُ الرهبةَ المقدّسةَ التي شعرتِ بها عندما دخلَ ملاكُ الربِّ مخدعَكِ وقال لكِ بأنكِ ستلدين رجاءَ إسرائيلَ ومُنتَظَرَ العالم. بواسطتكِ وبفضلِ الـ «نَعَم» التي قلتيها، كان على الرجاء المنتَظَرِ منذُ آلافِ السنين أن يَغدوَ واقعاً، أن يدخُلَ في هذا العالم وفي تاريخه. لقد انحنيتِ أمامَ عظَمَةِ هذه المُهمّة وقلتِ «نَعَم»: «ها أنذا أمةُ الربِّ، ليكن لي بحسبِ قولكَ» (لو 1 / 38). وعندما كنتِ مملوءةً بالفرحِ وعَبَرتِ بسرعةٍ جبالَ اليهوديةِ لتصلي عندَ نسيبتِكِ أليصابات، قد صرتِ الكنيسةِ المستقبليّة التي تحملُ في داخلها رجاءَ العالمِ عَبرَ جبالِ التاريخ. مع الفرحِ الذي نشرتيهِ عَبرَ السنين من خلالِ ترديدنا وترتيلنا نشيدَكِ «تعظِّمُ نفسيّ الربَّ»، كنتِ على علمٍ أيضاً بأقوالِ الأنبياء الغامضة، التي تحدّثوا فيها عن ألَمِ عبدِ الله في هذا العالم. عند الميلادِ في مذود بيتِ لحم أشرَقَ ضياءُ الملائكةِ الذين حَمَلوا الخبرَ السارَّ للرعاة، لكن في نفس الوقت صار فقرُ الله في هذا العالم ملموساً إلى أقصى الحدود. لقد كلّمكِ الشيخُ سمعان عن السيفِ الذي كان سينفذُ في قلبك (راجع لو 2 / 35)، عن كون ابنكِ آيةً معرَّضةً للرفضِ في العالم. وعندما بدأ يسوعُ نشاطه العلنيّ كان عليكِ أن تتنحّي جانباً، في سبيل نموّ العائلة الجديدة التي أتى لأجلِ تأسيسها وهي تتطورُ بفضلِ مساهمةِ أولئكَ الذين سمعوا كلمته وحفظوها (راجع لو 11 / 27 وما يليه). وبالرغم من كل الفرح الذي رافقَ انطلاقةَ نشاطِ يسوع، كانَ عليكِ أن تختبري في مَجمَع الناصرة حقيقةَ «الآية المعرّضةِ للرفض» (راجع لو 4 / 28 وما يليه). هكذا قد رأيتِ سلطانَ الحقدِ المتزايدِ والرفضِ المتصاعِدِ تجاه يسوع حتى ساعةِ الصليب، حيث كان عليكِ أن تري مُخلِّصَ العالم، وريثَ داود، ابن الله يموت بين الأشرار، كفاشلٍ يسخرون منه. فقبلت عندئذٍ الكلمة: «يا امرأة، هذا ابنك!» (يو 19 / 26). ومن على الصليب أعطيتِ مُهمَّةً جديدة. فمن الصليب أصبحتِ أماً بطريقةٍ جديدة: أماً لكل الذين يريدون الإيمانَ بإبنكِ يسوع واتباعه. لقد نَفَذَ سيفُ الآلامِ قلبَكِ. فهل مات الرجاءُ؟ هل بقيَ العالمُ دونَ نورٍ نهائياً، وهل بقيتِ الحياةُ دون هدفٍ؟ في تلكَ الساعةِ قد سمعتِ، على الأغلب، في قلبكِ كلمةُ الملاكِ تتردَّدُ من جديد، تلك التي بها أجاب عن خوفكِ في لحظةِ البشارة: «لا تخافي، مريم!» (لو 1 / 30). كم مرةً كان قد ردّدها الربُّ ابنُك لتلاميذه: لا تخافوا! في ليلِ الجلجثة قد سمعتِ من جديدٍ هذه الكلمة. قبل ساعةِ تسلميه قد قال لتلاميذه: «ثقوا! فقد غلبتُ العالم» (يو 16 / 33). «لا تضطرب قلوبكم ولا تفزع» (يو 14 / 27). «لا تخافي، مريم!» يومَ البشارة قال لكِ الملاكُ أيضاً: «لن يكونَ لمُلكِهِ نهاية» (لو 1 / 33). فهل كان مُلْكُهُ قد انتهى قبل أن يبدأ؟ لا، عند الصليبِ، وحسبَ كلمة يسوعَ نفسها، أنتِ قد صرتِ أمَّ المؤمنين. بهذا الإيمان، الذي كانَ لكِ رجاءً أكيداً حتى في ظلامِ السبتِ المقدّس، قد سِرتِ نحوَ صباحِ الفصح. لقد لمسَ فرحُ القيامةِ قلبَكِ ووحَّدَكِ مع التلاميذِ بشكلٍ جديد، التلاميذ المزمعينَ أن يصيروا عائلةَ يسوع بفضلِ الإيمان. هكذا كنتِ موجودةً في وسط جماعةِ المؤمنين، الذين اجتمعوا ليُصلّوا بنفسٍ واحدةٍ بعد صعودِ الربِّ ليطلبوا عطيةَ الروح القدس (راجع أع 1 / 14) فنالوه في يوم العنصرة. لقد كان «ملكوت» يسوعَ مختلفاً عما تصّوره الناس. ذاك «الملكوت» الذي بدأ في تلك الساعة دون أن يكون له انقضاء. هكذا تظلّين أنتِ بين التلاميذِ كأمٍ لهم، كأمِّ الرجاء. يا قديسة مريم، يا والدةَ الله، علّمينا أن نؤمن، أن نرجو وأن نحبّ معكِ. أرشدينا الطريقَ نحوَ ملكوتِهِ! يا نجمةَ البحرِ، أشرقي علينا وسيري أمامَنا في الدرب!
أعطيَت في روما، قرب القديس بطرس
في 30 / تشرين الثاني
في عيد القديس أندراوس الرسول
عام 2007، الثالث لحبريّتنا
بندكتس السادس عشر
الحواشي:
39) المرجع السابق، الأعداد 1030 – 1032.
40) المرجع السابق، العدد 1032.
ترجمة الموسوعة العربية المسيحية: نؤمن بإله واحد (ترجمة غير رسمية) |
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى