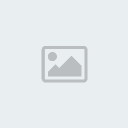مايكل عادلعضو نشيط
مايكل عادلعضو نشيط
 الرسالة العامة (بالرجاء مخلصون)8 البابا بندكتس
الرسالة العامة (بالرجاء مخلصون)8 البابا بندكتس
الأربعاء مايو 14, 2008 3:58 pm
بالرجاء مخلصونSpe Salvi
29- في نظر أغسطينوس هذا يعني حياةً جديدةً بالكامل. هكذا وصفَ إحدى المرات حياته اليومية: «إصلاحُ غير المنضبطين، رفعُ معنوياتِ الضعفاء، تثبيتُ الواهنين، دَحضُ المُعارضين، الإحتراسُ من الأشرار، تعليمُ الجاهلين، حثُّ الكسولين، كبحُ العِدائيين، تعديلُ المتكبرين، تشجيعُ اليائسين، إحلالُ السلامِ بينَ المتخاصمين، تقوية الصالحين، احتمالُ الأشرار و [آهٍ!] محبةُ الجميع» [22]. «الإنجيلُ يُرهبُني» [23] – هي الرهبة السليمة التي تمنعنا من العيشِ لذواتنا وتدفعنا على نشرِ رجاءنا المشترك. في الواقع، كانت هذه نيةُ أغسطينوس: نشرُ الرجاء وقتَ كان وضعُ الإمبراطورية الرومانية الصعبِ يُهدِّدُ إفريقيا التي كانت تحت الحكم الروماني أيضاً، والذي في نهاية حياةِ أغسطينوس وصل الحدُّ لتدميرها – إنَّ الرجاءَ، الآتي من الإيمانِ والمتضارب مع طبيعةِ أغسطينوس المنغَلقة، قد جعلَه قادراً على الإشتراكِ بطريقةٍ حاسمةٍ وبجميعِ قواهُ في بناءِ المدينة. يقول أغسطينوس، في نفس الفصل من كتاب الإعترافات الذي رأينا فيهِ سببَ اجتهادهِ الحاسمَ «لأجل الجميع»: إن المسيحَ «يشفعُ لنا، ولولا ذلكَ لأصابني اليأسُ. كثيرةٌ وثقيلة هي الضعفات، كثيرةٌ وثقيلة، لكن علاجَكَ فياضٌ. لولا أن كلمتكَ صارت جسداً وسكنت بيننا، لكُنّا اعتقدنا أنها بعيدة عن نطاق البشر ولكُنّا قد يئسنا من أنفسنا» [24]. بقوّةِ رجائِهِ، وهبَ أغسطينوس نفسَهُ في سبيلِ البسطاءِ من الناسِ وفي سبيلِ مدينته – لقد ضحّى بروحانية النبلاء ليكرُزَ ويعملَ ببساطةٍ لأجلِ البسطاء.
30- لنلخِّص ما توصلنا إليهِ في تأملاتنا حتى الآن. للإنسانِ في تعاقبِ أيامهِ آمالٌ كثيرة – صغيرة أو كبيرة – تختلفُ بإختلافِ فتراتِ الحياة. وأحياناً يمكن لواحدٍ من هذه الآمال أن يبدوَ وكأنهُ كافٍ ليُشبعَ صاحبه تماماً فلا يحتاجُ بذلكَ إلى آمالٍ أخرى. ففي فترة الشباب يمكنُ أن يكونَ الأملُ أملَ الحبِّ الكبير والمُشبِع؛ أملَ مرتبةٍ في العملِ، أملَ نجاحٍ ما يضمنُ لبقيّةِ الحياة اتجاهاً حاسماً. لكن عندما تتحقق هذه الآمال، يظهرُ جليّاً أنها لم تكن في الواقع كلُّ شيء. ويتبيَّن بوضوحٍ أن الإنسانَ بحاجةٍ لرجاءٍ أبعدَ من ذلك. يتبيَّنُ بوضوحٍ أنه لن يكتفي إلا باللامحدود، بالشيء الذي يبقى أعظم من كلِّ ما يمكن الوصولُ إليه. بهذا المعنى قد توصَّلَ عصرُنا الحاضرُ إلى التفكير في رجاءِ إقامةِ عالمٍ كاملٍ، يبدو أنه قابلٌ للتحقيقِ بفضلِ معارف العلمِ والسياسةِ المؤسَّسةِ عليهِ. هكذا استُبدِلَ رجاءُ الكتاب المقدس في ملكوتِ اللهِ برجاءِ ملكوت الإنسان، برجاءِ عالمٍ أفضل قد اعتُبِرَ «ملكوتُ الله» الحقيقيّ. لقد بدا هذا في آخر الأمر وكأنه الرجاءُ الكبيرُ والواقعيّ الذي كان الإنسانُ بحاجةٍ إليه. كان هذا الرجاءُ قادراً على تحريك جميع قوى البشرية لوقتٍ معيَّنٍ؛ فالهدف العظيم يستحقُّ كلَّ جهدٍ. لكن مع مرور الوقت ظهرَ واضحاً أن هذا الرجاء كان يهرب بعيداً بشكلٍ دائم. لقد غدا جليّاً – قبل كل شيء – أن رجاءً كهذا هو لأناسِ ما بعد الغدِ وليس لي. وبالرغم من أن فكرة «لأجل الجميع» هي جزءٌ من هذا الرجاء – ذاكَ أنه لا يمكنني أن أصبح سعيداً ضدَّ الآخرينَ أو بدونهم – يبقى صحيحاً أن الرجاءَ إنْ لَمْ يخصّني أنا شخصياً هو ليسَ رجاءً حقيقياً. وأصبحَ واضحاً أن هذا كانَ رجاءٌ ضدّ الحرية، لأن وضعَ الأمورِ البشريّةِ يعتمد في كلِّ جيلٍ من جديد على قرار أبنائِهِ الحرِّ. فلو حُرموا من حريتهم هذه، بسببِ الأحوالِ والتنظيماتِ، لن يكونَ العالمُ صالحاً، لأن العالمَ دونَ الحرية هو ليس عالماً صالحاً. لهذا، وبالرغمِ من ضرورةِ الإجتهادِ المتواصل في سبيل تحسين العالم، لا يمكن لعالمِ الغدِ الأفضل أن يُصبحَ موضوعَ رجائنا الحقيقيّ والكافي. لهذا يطرحُ السؤال دائماً في هذا الشأنِ: متى يكون العالمُ «أفضلَ»؟ ما هو الشيء الذي يجعله صالحاً؟ ما هو المعيارُ الذي يُحدِّدُ مقدارَ صلاحِهِ؟ وما هي الطرقٌ التي تودي بنا إلى هذا «الصلاح»؟
31- وماذا بعد؟: نحنُ بحاجةٍ للآمال – صغيرة كانت أم كبيرة – لأنها تُدفُعنا لمواصلةِ السير يوماً بعد الآخر. لكنها لا تكفي وحدها إن لم يكن هناكَ الرجاءُ الأعظمُ الذي يفوقها جميعاً. هذا الرجاءُ الأعظَم هو الله وحده، هو الذي يُعانِقُ الكون بأسره وهو القادرُ أن يقترحَ علينا ويهبنا ما لا نستطيعُ نحنُ بمفردنا أن نصلَ إليه. والواقع أن هبَتَهُ التي تشبعنا هي جزءٌ من الرجاء. الله هو أساسُ الرجاء، وهنا لا نتكلم عن إلهٍ مجهولٍ، بل عن ذاكَ الإلهُ ذو الوجهِ الإنسانيِّ، ذاك الذي أحبنا إلى المنتهي: أحبَّ كلَّ فردٍ كما أحبَّ البشريةَ جمعاء. ملكوتُه ليس بعيداً وليس هو بخيالاتٍ في مستقبلٍ لن يتحقق أبداً؛ ملكوته حاضرٌ حيثُ هو محبوبٌ وحيثُ تصِلُنا محبته. وحدها محبتهُ تجعلنا قادرينَ على أن نثابرَ بجديّةٍ يوماً بعدَ يوم، دونَ أن نخسَرَ سببَ رجائنا، في عالمٍ غير كامل بطبيعته. في نفس الوقت محبته لنا هي ضمانٌ لوجودُ ذاكَ الشيء الذي نتحسَّسُهُ بغموضٍ ومع ذلكَ ننتظره في أعماق نفوسنا: الحياة التي هي «حقاً» حياة. سنحاول أن نشرحَ هذه الفكرة بشكلٍ عمليٍّ في القسم الأخير، وذلك بالحديث عن بعض «الأماكن» التي تساعدنا على فهم الرجاءِ وممارسته عملياً.
«أماكن» فهم الرجاء وممارسته عملياً
أولاً: الصلاة كمدرسةِ رجاء
32- المكان الأول والجوهري لفهم الرجاء هو الصلاة. حتى ولو أن الجميعَ رفضوا أن يُصغوا لي، يبقى الله يصغي لي. وإن لم أعُدْ قادراً على التحدُّثِ مع أحد أو اللجوء لأحدٍ ما، أستطيعُ التحدُّثَ مع الله دائماً. إن لَم يَعُدْ هناك مَن يُساعدني – حين احتاجُ أمراً ما أو آملُ بما يفوقُ القدرات البشرية – هو يستطيعُ مساعدتي [25]. إن كنتُ متروكاً في أقصى درجاتِ الوحدة...؛ لكن من يُصلّي لا يكون أبداً وحيداً. لقد تركَ لنا الكاردينال نغوين فان توان، كثمرةِ ثلاثةَ عشرَ عاماً من السجنِ، قضى منها تسعة أعوامٍ في زنزانةٍ فردية، كُتيِّباً ثميناً عنوانه صلواتُ رجاء. خلالَ ثلاثة عشر عاماً من السجنِ في حالةٍ كانت تبدو وكأنها داعيةً لليأس الكامل، كانَ يُشكِّلُ إصغاءُ الله لهُ، وقدرتُهُ على التحدُّثِ مع الله، قوةَ رجاءٍ متواصلٍ، وبعدَ إطلاقِ سراحهِ جَعَلَ منهُ شاهدَ رجاءٍ للبشر في كل أنحاءِ العالم – شاهداً لذاك الرجاء العظيم الذي لا يغرب نوره حتى في عتمةِ ليالي الوحدة.
33- في عظته عن رسالة يوحنا الأولى، أوضح القديس أغسطينوس بطريقةٍ رائعةٍ العلاقة الوثيقةَ بين الصلاةِ والرجاء. فقد وصفَ الصلاة على أنها تمرينٌ للرغبةِ. لقد خُلِقَ الإنسانُ لأجلِ غايةٍ عظيمةٍ – لأجل الله نفسه، كي يمتلأَ به. لكنَّ قلبَه صغيرٌ جداً بالمقارنةِ مع هذه الغايةِ العظيمةِ التي صُنعَ لأجلها. لهذا يجب على قلبه هذا أن يتوسَّعَ. «بإرساله عطيَّته، يوسِّعُ اللهُ رغبَتَنا؛ وعن طريقِ الرغبةِ يوسِّعُ النفسَ، وبهذا يجعلها أكثرَ قدرةً على قبوله هو [أي الله]». يذكرُ أغسطينوس هنا القديس بولس الذي يقولُ عن نفسهِ بأنه يحيا مشدوداً نحو الأمورِ الآتيةِ (راجع فيل 3 / 13). ثم يستعملُ صورةً رائعةً ليَصِفَ عمليَّةَ توسيعِ القلب البشريّ وتحضيره. «افترض أن الله يريدُ أن يملأكَ عسلاً [رمزَ حنانه وصلاحه]. لكن إن كنتَ مليئاً بالخلِّ فأينَ يضعُ العسل؟». على الإنسانِ أولاً أن يوسِّعَ قلبه ومن ثمَّ عليهِ أنْ يُطهرَهُ: عليهِ أن يُحرَّرَ مِن الخلِّ ومِن طعمِهِ. هذا يتطلَّبُ جهداً ويُكلِّفُ ألماً، لكن هكذا فقط يُصبح ملائماً للغاية التي خُلقَ من أجلها [26]. وبالرغم من أن أغسطينوس يتكلّمُ بشكلٍ مباشرٍ عن قبولنا لله، إلا أنه يَظهرُ واضحاً أنَّ الإنسانَ في جهدهِ هذا للتحرُّرِ مِن الخلِّ ومن طعمه، لا يُصبحُ حراً فقط لأجل الله، لكنه ينفتحُ على الآخرينَ أيضاً. فقط في صيرورتنا أبناءً لله نستطيعُ أن نبقى مع أبينا المُشتَرك. الصلاةُ الصحيحةُ هي عمليةُ تطهيرٍ داخليٍّ تجعلنا منفتحين على الله وبالتالي على البشرِ أيضاً. على الإنسان أن يتعلمَ من خلالِ الصلاة ما الذي يستطيعُ حقاً أن يطلبه من الله – ما هو الشيءُ اللائقُ بالله. عليه أن يتعلَّمَ أنه لا يستطيعُ أن يُصلّي ضدَّ الآخر. عليه أن يتعلَّمَ أنه لا يستطيعُ أن يطلبَ الأشياءَ السطحيةَ والمُريحةَ التي يرغبها في لحظته الحاضرة، لا يستطيعُ أن يطلبَ تحقيقَ أملٍ صغيرٍ خاطئٍ يُبعده عن الله. عليهِ أن يُطهِّرَ رغباتِهِ وآمالَه. عليه أن يتحرَّرَ من الكذبات المستَتِرة التي يخدع بها نفسه: الله يعرفها، واللقاءُ مع الله يقودُ الإنسانَ حتماً إلى الإعترافِ بها هو أيضاً. «الزلاتُ مَن يتبيَّنها يا ربُّ؟ فمِنَ الخطايا المُستترةِ نقِّني» يُصلّي صاحبُ المزمورِ (مز 19 [18] / 13). إن عدمَ الإعترافِ بالذنْبِ ووهمِ البراءةِ لا يمكنهما أن يُبرِّراني أو أن يُخلِّصاني، لأنَّ غفوةَ الضميرِ وعدم قدرتي على الإعترافِ بالشرِّ الذي فيَّ على أنه شرٌّ، هو ذَنبي أنا. إنْ لَم يكن اللهُ موجوداً، ربما كانَ عليَّ أن ألتجئ إلى أكاذيبٍ كهذه، لأنني لم أكن لأجدَ مَن يغفر لي، مَن يُشكِّلُ مِقياساً للحقيقةِ بالنسبة لي. أمّا اللقاءُ مع الله فيوقِظُ ضميري، كي لا يعودَ ويبرِّرني ولا يكن إنعكاساً لذاتي ولمن هم حولي ممَّن يؤثّرون عليَّ، بل يغدو قدرةً على الإصغاءِ لمَن هو الصلاحُ في ذاته.
34- كيما تُنتِجُ الصلاةُ هذه القوةَ المُطهِّرة، عليها أن تكونَ من جهةٍ، صلاةً شخصية، لقاءً يجمعني مع الله، مع الله الحي. من جهةٍ أخرى عليها أن تسيرَ دائماً على هُدى صلواتِ الكنيسةِ والقديسين الكبرى وتستنيرَ بها بالإضافةِ للصلاةِ الليتورجيةِ التي بها يُعلّمنا الربُّ بإستمرارٍ كيف نصلّي بطريقةٍ صحيحة. لقد سَرَدَ الكارينال نغوين فان توان في كتابه "التمارين الروحية" كيفَ أنه مرَّ أثناءَ حياتِهِ بفتراتٍ طويلةٍ عَجِزَ فيها عن الصلاة وكيفَ أنه تعلَّقَ بكلماتِ صلاةِ الكنيسةِ: صلاة الأبانا والسلام والصلوات الليتورجية [27]. في الصلاة يجب أن تتضافر دائماً صلاةُ الجماعةِ مع الصلاةِ الشخصية، هكذا نستطيعُ أن نتحدَّثَ إلى الله، هكذا يتحدَّثُ اللهُ معنا. هكذا نتطهَّرُ ونصبحُ منفتحينَ على الله ومُؤَهَّلينَ لخدمة البشر. هكذا نصبحُ منفتحينَ على الرجاء الأعظم ونغدوا خُدّامَ الرجاء في سبيل الآخرين: الرجاءُ في المفهوم المسيحيّ هو دائماً رجاءٌ في سبيلِ الآخرين. وهو رجاءٌ فاعلٌ، به نجاهدُ كي لا تسيرَ الأمورُ نحو «نهايةٍ فاسدة». هو رجاءٌ فاعلٌ لأنه يجعلُ من العالمِ عالماً منفتحاً على الله. هكذا فقط يكونُ الرجاءُ رجاءً إنسانياً بكل معنى الكلمة.
.
29- في نظر أغسطينوس هذا يعني حياةً جديدةً بالكامل. هكذا وصفَ إحدى المرات حياته اليومية: «إصلاحُ غير المنضبطين، رفعُ معنوياتِ الضعفاء، تثبيتُ الواهنين، دَحضُ المُعارضين، الإحتراسُ من الأشرار، تعليمُ الجاهلين، حثُّ الكسولين، كبحُ العِدائيين، تعديلُ المتكبرين، تشجيعُ اليائسين، إحلالُ السلامِ بينَ المتخاصمين، تقوية الصالحين، احتمالُ الأشرار و [آهٍ!] محبةُ الجميع» [22]. «الإنجيلُ يُرهبُني» [23] – هي الرهبة السليمة التي تمنعنا من العيشِ لذواتنا وتدفعنا على نشرِ رجاءنا المشترك. في الواقع، كانت هذه نيةُ أغسطينوس: نشرُ الرجاء وقتَ كان وضعُ الإمبراطورية الرومانية الصعبِ يُهدِّدُ إفريقيا التي كانت تحت الحكم الروماني أيضاً، والذي في نهاية حياةِ أغسطينوس وصل الحدُّ لتدميرها – إنَّ الرجاءَ، الآتي من الإيمانِ والمتضارب مع طبيعةِ أغسطينوس المنغَلقة، قد جعلَه قادراً على الإشتراكِ بطريقةٍ حاسمةٍ وبجميعِ قواهُ في بناءِ المدينة. يقول أغسطينوس، في نفس الفصل من كتاب الإعترافات الذي رأينا فيهِ سببَ اجتهادهِ الحاسمَ «لأجل الجميع»: إن المسيحَ «يشفعُ لنا، ولولا ذلكَ لأصابني اليأسُ. كثيرةٌ وثقيلة هي الضعفات، كثيرةٌ وثقيلة، لكن علاجَكَ فياضٌ. لولا أن كلمتكَ صارت جسداً وسكنت بيننا، لكُنّا اعتقدنا أنها بعيدة عن نطاق البشر ولكُنّا قد يئسنا من أنفسنا» [24]. بقوّةِ رجائِهِ، وهبَ أغسطينوس نفسَهُ في سبيلِ البسطاءِ من الناسِ وفي سبيلِ مدينته – لقد ضحّى بروحانية النبلاء ليكرُزَ ويعملَ ببساطةٍ لأجلِ البسطاء.
30- لنلخِّص ما توصلنا إليهِ في تأملاتنا حتى الآن. للإنسانِ في تعاقبِ أيامهِ آمالٌ كثيرة – صغيرة أو كبيرة – تختلفُ بإختلافِ فتراتِ الحياة. وأحياناً يمكن لواحدٍ من هذه الآمال أن يبدوَ وكأنهُ كافٍ ليُشبعَ صاحبه تماماً فلا يحتاجُ بذلكَ إلى آمالٍ أخرى. ففي فترة الشباب يمكنُ أن يكونَ الأملُ أملَ الحبِّ الكبير والمُشبِع؛ أملَ مرتبةٍ في العملِ، أملَ نجاحٍ ما يضمنُ لبقيّةِ الحياة اتجاهاً حاسماً. لكن عندما تتحقق هذه الآمال، يظهرُ جليّاً أنها لم تكن في الواقع كلُّ شيء. ويتبيَّن بوضوحٍ أن الإنسانَ بحاجةٍ لرجاءٍ أبعدَ من ذلك. يتبيَّنُ بوضوحٍ أنه لن يكتفي إلا باللامحدود، بالشيء الذي يبقى أعظم من كلِّ ما يمكن الوصولُ إليه. بهذا المعنى قد توصَّلَ عصرُنا الحاضرُ إلى التفكير في رجاءِ إقامةِ عالمٍ كاملٍ، يبدو أنه قابلٌ للتحقيقِ بفضلِ معارف العلمِ والسياسةِ المؤسَّسةِ عليهِ. هكذا استُبدِلَ رجاءُ الكتاب المقدس في ملكوتِ اللهِ برجاءِ ملكوت الإنسان، برجاءِ عالمٍ أفضل قد اعتُبِرَ «ملكوتُ الله» الحقيقيّ. لقد بدا هذا في آخر الأمر وكأنه الرجاءُ الكبيرُ والواقعيّ الذي كان الإنسانُ بحاجةٍ إليه. كان هذا الرجاءُ قادراً على تحريك جميع قوى البشرية لوقتٍ معيَّنٍ؛ فالهدف العظيم يستحقُّ كلَّ جهدٍ. لكن مع مرور الوقت ظهرَ واضحاً أن هذا الرجاء كان يهرب بعيداً بشكلٍ دائم. لقد غدا جليّاً – قبل كل شيء – أن رجاءً كهذا هو لأناسِ ما بعد الغدِ وليس لي. وبالرغم من أن فكرة «لأجل الجميع» هي جزءٌ من هذا الرجاء – ذاكَ أنه لا يمكنني أن أصبح سعيداً ضدَّ الآخرينَ أو بدونهم – يبقى صحيحاً أن الرجاءَ إنْ لَمْ يخصّني أنا شخصياً هو ليسَ رجاءً حقيقياً. وأصبحَ واضحاً أن هذا كانَ رجاءٌ ضدّ الحرية، لأن وضعَ الأمورِ البشريّةِ يعتمد في كلِّ جيلٍ من جديد على قرار أبنائِهِ الحرِّ. فلو حُرموا من حريتهم هذه، بسببِ الأحوالِ والتنظيماتِ، لن يكونَ العالمُ صالحاً، لأن العالمَ دونَ الحرية هو ليس عالماً صالحاً. لهذا، وبالرغمِ من ضرورةِ الإجتهادِ المتواصل في سبيل تحسين العالم، لا يمكن لعالمِ الغدِ الأفضل أن يُصبحَ موضوعَ رجائنا الحقيقيّ والكافي. لهذا يطرحُ السؤال دائماً في هذا الشأنِ: متى يكون العالمُ «أفضلَ»؟ ما هو الشيء الذي يجعله صالحاً؟ ما هو المعيارُ الذي يُحدِّدُ مقدارَ صلاحِهِ؟ وما هي الطرقٌ التي تودي بنا إلى هذا «الصلاح»؟
31- وماذا بعد؟: نحنُ بحاجةٍ للآمال – صغيرة كانت أم كبيرة – لأنها تُدفُعنا لمواصلةِ السير يوماً بعد الآخر. لكنها لا تكفي وحدها إن لم يكن هناكَ الرجاءُ الأعظمُ الذي يفوقها جميعاً. هذا الرجاءُ الأعظَم هو الله وحده، هو الذي يُعانِقُ الكون بأسره وهو القادرُ أن يقترحَ علينا ويهبنا ما لا نستطيعُ نحنُ بمفردنا أن نصلَ إليه. والواقع أن هبَتَهُ التي تشبعنا هي جزءٌ من الرجاء. الله هو أساسُ الرجاء، وهنا لا نتكلم عن إلهٍ مجهولٍ، بل عن ذاكَ الإلهُ ذو الوجهِ الإنسانيِّ، ذاك الذي أحبنا إلى المنتهي: أحبَّ كلَّ فردٍ كما أحبَّ البشريةَ جمعاء. ملكوتُه ليس بعيداً وليس هو بخيالاتٍ في مستقبلٍ لن يتحقق أبداً؛ ملكوته حاضرٌ حيثُ هو محبوبٌ وحيثُ تصِلُنا محبته. وحدها محبتهُ تجعلنا قادرينَ على أن نثابرَ بجديّةٍ يوماً بعدَ يوم، دونَ أن نخسَرَ سببَ رجائنا، في عالمٍ غير كامل بطبيعته. في نفس الوقت محبته لنا هي ضمانٌ لوجودُ ذاكَ الشيء الذي نتحسَّسُهُ بغموضٍ ومع ذلكَ ننتظره في أعماق نفوسنا: الحياة التي هي «حقاً» حياة. سنحاول أن نشرحَ هذه الفكرة بشكلٍ عمليٍّ في القسم الأخير، وذلك بالحديث عن بعض «الأماكن» التي تساعدنا على فهم الرجاءِ وممارسته عملياً.
«أماكن» فهم الرجاء وممارسته عملياً
أولاً: الصلاة كمدرسةِ رجاء
32- المكان الأول والجوهري لفهم الرجاء هو الصلاة. حتى ولو أن الجميعَ رفضوا أن يُصغوا لي، يبقى الله يصغي لي. وإن لم أعُدْ قادراً على التحدُّثِ مع أحد أو اللجوء لأحدٍ ما، أستطيعُ التحدُّثَ مع الله دائماً. إن لَم يَعُدْ هناك مَن يُساعدني – حين احتاجُ أمراً ما أو آملُ بما يفوقُ القدرات البشرية – هو يستطيعُ مساعدتي [25]. إن كنتُ متروكاً في أقصى درجاتِ الوحدة...؛ لكن من يُصلّي لا يكون أبداً وحيداً. لقد تركَ لنا الكاردينال نغوين فان توان، كثمرةِ ثلاثةَ عشرَ عاماً من السجنِ، قضى منها تسعة أعوامٍ في زنزانةٍ فردية، كُتيِّباً ثميناً عنوانه صلواتُ رجاء. خلالَ ثلاثة عشر عاماً من السجنِ في حالةٍ كانت تبدو وكأنها داعيةً لليأس الكامل، كانَ يُشكِّلُ إصغاءُ الله لهُ، وقدرتُهُ على التحدُّثِ مع الله، قوةَ رجاءٍ متواصلٍ، وبعدَ إطلاقِ سراحهِ جَعَلَ منهُ شاهدَ رجاءٍ للبشر في كل أنحاءِ العالم – شاهداً لذاك الرجاء العظيم الذي لا يغرب نوره حتى في عتمةِ ليالي الوحدة.
33- في عظته عن رسالة يوحنا الأولى، أوضح القديس أغسطينوس بطريقةٍ رائعةٍ العلاقة الوثيقةَ بين الصلاةِ والرجاء. فقد وصفَ الصلاة على أنها تمرينٌ للرغبةِ. لقد خُلِقَ الإنسانُ لأجلِ غايةٍ عظيمةٍ – لأجل الله نفسه، كي يمتلأَ به. لكنَّ قلبَه صغيرٌ جداً بالمقارنةِ مع هذه الغايةِ العظيمةِ التي صُنعَ لأجلها. لهذا يجب على قلبه هذا أن يتوسَّعَ. «بإرساله عطيَّته، يوسِّعُ اللهُ رغبَتَنا؛ وعن طريقِ الرغبةِ يوسِّعُ النفسَ، وبهذا يجعلها أكثرَ قدرةً على قبوله هو [أي الله]». يذكرُ أغسطينوس هنا القديس بولس الذي يقولُ عن نفسهِ بأنه يحيا مشدوداً نحو الأمورِ الآتيةِ (راجع فيل 3 / 13). ثم يستعملُ صورةً رائعةً ليَصِفَ عمليَّةَ توسيعِ القلب البشريّ وتحضيره. «افترض أن الله يريدُ أن يملأكَ عسلاً [رمزَ حنانه وصلاحه]. لكن إن كنتَ مليئاً بالخلِّ فأينَ يضعُ العسل؟». على الإنسانِ أولاً أن يوسِّعَ قلبه ومن ثمَّ عليهِ أنْ يُطهرَهُ: عليهِ أن يُحرَّرَ مِن الخلِّ ومِن طعمِهِ. هذا يتطلَّبُ جهداً ويُكلِّفُ ألماً، لكن هكذا فقط يُصبح ملائماً للغاية التي خُلقَ من أجلها [26]. وبالرغم من أن أغسطينوس يتكلّمُ بشكلٍ مباشرٍ عن قبولنا لله، إلا أنه يَظهرُ واضحاً أنَّ الإنسانَ في جهدهِ هذا للتحرُّرِ مِن الخلِّ ومن طعمه، لا يُصبحُ حراً فقط لأجل الله، لكنه ينفتحُ على الآخرينَ أيضاً. فقط في صيرورتنا أبناءً لله نستطيعُ أن نبقى مع أبينا المُشتَرك. الصلاةُ الصحيحةُ هي عمليةُ تطهيرٍ داخليٍّ تجعلنا منفتحين على الله وبالتالي على البشرِ أيضاً. على الإنسان أن يتعلمَ من خلالِ الصلاة ما الذي يستطيعُ حقاً أن يطلبه من الله – ما هو الشيءُ اللائقُ بالله. عليه أن يتعلَّمَ أنه لا يستطيعُ أن يُصلّي ضدَّ الآخر. عليه أن يتعلَّمَ أنه لا يستطيعُ أن يطلبَ الأشياءَ السطحيةَ والمُريحةَ التي يرغبها في لحظته الحاضرة، لا يستطيعُ أن يطلبَ تحقيقَ أملٍ صغيرٍ خاطئٍ يُبعده عن الله. عليهِ أن يُطهِّرَ رغباتِهِ وآمالَه. عليه أن يتحرَّرَ من الكذبات المستَتِرة التي يخدع بها نفسه: الله يعرفها، واللقاءُ مع الله يقودُ الإنسانَ حتماً إلى الإعترافِ بها هو أيضاً. «الزلاتُ مَن يتبيَّنها يا ربُّ؟ فمِنَ الخطايا المُستترةِ نقِّني» يُصلّي صاحبُ المزمورِ (مز 19 [18] / 13). إن عدمَ الإعترافِ بالذنْبِ ووهمِ البراءةِ لا يمكنهما أن يُبرِّراني أو أن يُخلِّصاني، لأنَّ غفوةَ الضميرِ وعدم قدرتي على الإعترافِ بالشرِّ الذي فيَّ على أنه شرٌّ، هو ذَنبي أنا. إنْ لَم يكن اللهُ موجوداً، ربما كانَ عليَّ أن ألتجئ إلى أكاذيبٍ كهذه، لأنني لم أكن لأجدَ مَن يغفر لي، مَن يُشكِّلُ مِقياساً للحقيقةِ بالنسبة لي. أمّا اللقاءُ مع الله فيوقِظُ ضميري، كي لا يعودَ ويبرِّرني ولا يكن إنعكاساً لذاتي ولمن هم حولي ممَّن يؤثّرون عليَّ، بل يغدو قدرةً على الإصغاءِ لمَن هو الصلاحُ في ذاته.
34- كيما تُنتِجُ الصلاةُ هذه القوةَ المُطهِّرة، عليها أن تكونَ من جهةٍ، صلاةً شخصية، لقاءً يجمعني مع الله، مع الله الحي. من جهةٍ أخرى عليها أن تسيرَ دائماً على هُدى صلواتِ الكنيسةِ والقديسين الكبرى وتستنيرَ بها بالإضافةِ للصلاةِ الليتورجيةِ التي بها يُعلّمنا الربُّ بإستمرارٍ كيف نصلّي بطريقةٍ صحيحة. لقد سَرَدَ الكارينال نغوين فان توان في كتابه "التمارين الروحية" كيفَ أنه مرَّ أثناءَ حياتِهِ بفتراتٍ طويلةٍ عَجِزَ فيها عن الصلاة وكيفَ أنه تعلَّقَ بكلماتِ صلاةِ الكنيسةِ: صلاة الأبانا والسلام والصلوات الليتورجية [27]. في الصلاة يجب أن تتضافر دائماً صلاةُ الجماعةِ مع الصلاةِ الشخصية، هكذا نستطيعُ أن نتحدَّثَ إلى الله، هكذا يتحدَّثُ اللهُ معنا. هكذا نتطهَّرُ ونصبحُ منفتحينَ على الله ومُؤَهَّلينَ لخدمة البشر. هكذا نصبحُ منفتحينَ على الرجاء الأعظم ونغدوا خُدّامَ الرجاء في سبيل الآخرين: الرجاءُ في المفهوم المسيحيّ هو دائماً رجاءٌ في سبيلِ الآخرين. وهو رجاءٌ فاعلٌ، به نجاهدُ كي لا تسيرَ الأمورُ نحو «نهايةٍ فاسدة». هو رجاءٌ فاعلٌ لأنه يجعلُ من العالمِ عالماً منفتحاً على الله. هكذا فقط يكونُ الرجاءُ رجاءً إنسانياً بكل معنى الكلمة.
.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى