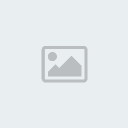مايكل عادلعضو نشيط
مايكل عادلعضو نشيط
 الرسالة العامة (بالرجاء مخلصون)6 البابا بندكتس
الرسالة العامة (بالرجاء مخلصون)6 البابا بندكتس
الأربعاء مايو 14, 2008 3:51 pm
بالرجاء مخلصونSpe Salvi
17- مَن يقرأ هذه التصريحات ويتأملها بتمعُّن يرى فيها تحوُّلاً يقلب الموازين: حتى تلك اللحظة كانت استعادةُ الإنسانِ لما فَقَدَه بعد طَرده من الفردوس تتم بواسطةِ الإيمان بيسوع المسيح، هذا كان معنى «الفداء». أما الآن فهذا «الفداء»، أي استعادة «الفردوس» المفقود لم يَعد يُعتَبر ثمرةً للإيمانِ بل ثمرةَ العلاقةِ المُكتشفةِ بين العلم وتطبيقاته العملية. هذا لا يعني ببساطة أن الإنسانَ قد أنكرَ الإيمان؛ لكنه قد حوَّله إلى مجالٍ آخر – أي المجال الفرديّ البحت ومجال الحياة الأبدية – وهكذا أصبح الإيمان دون أهميةٍ بالنسبة للعالم. لقد رَسَمَتْ هذه النظرةُ للإيمان برنامجاً يسيرُ عليهِ عصرُنا الحاضر وما زال لها دورٌ في أزمةِ الإيمانِ الحالية، والتي هي قبْلَ كل شيءٍ أزمةَ رجاءٍ مسيحيّ. هكذا قد اكتسب الرجاءُ في مفهوم باكون شكلاً جديداً. فأصبح اسمه: الإيمان بالتطور. كان واضحاً بالنسبة لباكون أن إكتشافات واختراعات عصره لم تكن سوى البداية؛ وأنه بفضلِ التناغمِ بين العلمِ وتطبيقاتِهِ العملية ستكون هناك اكتشافاتٌ جديدةٌ جذريةٌ، وبهذا سيظهرُ عالمٌ جديدٌ تماماً، إنه ملكوتُ الإنسان [16]. هكذا قد سَبق وتحدَّث باكون عن الإختراعات المستقبلية – حتى وصل إلى الطائرةِ والغواصة. وهكذا بينما تابعت أيدولوجية التطور هذه إزدهارها لاحقاً، تعَزَّزَ إيمانُ الإنسانِ بها لأنه كان يفرحُ إذ يرى قِواهُ تتقدم بشكلٍ ملموس بواسطتها.
18- في نفس الوقت إزدادت بإستمرارٍ مِحوريةُ نقطتين في فكرةِ التطور: العقلُ والحرية. فالتطور كان يعني قبل كل شيء إزديادُ سيطرةِ العقلِ بإعتباره قدرةً على الخير ولأجل الخير. فالتطورُ يعني إذاً مسيرةً نحو الإستقلالية، تطورٌ نحوَ الحريةِ الكاملة. والحريةُ اعتُبرَت بدورها وعدٌ بهِ يُحقق الإنسانُ ذاتَهُ في مسيرتِهِ نحو الملء. فكانَ لكلتا النقطتين – الحرية والعقل – بُعدٌ سياسيّ. فالإنسانيةُ صارت تنتظرُ ملكوتَ العقلِ كحالةٍ جديدةٍ فيها تجدُ حريّتها التامة. أما الشروطُ السياسيةُ اللازمةُ لملكوتِ العقلِ والحريةِ هذا فيبدو أنها لمْ تكن ذاتَ معالمٍ واضحةٍ بشكلٍ فوريّ. فكانَ يُعتَقد أن العقلَ والحريةَ – بفضلِ صلاحِهِم الجوهريّ – قادرَين على ضمانِ جماعةٍ إنسانيّةٍ جديدةٍ وكاملة. لكن في نفسِ الوقت ومن خلالِ هذين المفهومَين الأساسيَين أي «العقل» و«الحرية» كانَ الفكرُ ينحلُّ بصمتٍ من روابطِ الإيمانِ والكنيسةِ، متضارباً معهما تماماً كتضاربِه مع أنظمةِ الدول آنذاك. فقد كانت هاتانِ النقطتانِ تحملانِ في ذاتِهِما مكنوناً ثورياً مُفجِّراً ذو قدرةٍ هائلة.
19- علينا أن نلقي نظرةً سريعةً على المرحلتَين الأساسيّتَين اللتين تشكلان مسيرةَ تحقيقِ هذا الرجاء بطريقةٍ سياسيةٍ، بسببِ أهميتهما الكبرى في مسيرةِ الرجاءِ المسيحي، في فهمهِ وديمومته.
فقد أتَتْ أولاً الثورةُ الفرنسيةُ التي حاولت أن تفرضَ سيطرةَ العقلِ والحريةِ بشكلٍ سياسيّ واقعيّ. في البداية نَظرتْ أوروبا عصرِ التنوير بإعجابٍ إلى هذهِ الأحداث، لكن فيما بَعد وأمامَ تطوراتِها جَعَلَت تفكّرُ من جديدٍ في مَعنى العقلِ والحرية.
هناكَ كتابان لعمانوئيل كانط، يُظهران جلياً ردةَ الفعلِ المزدوجةِ أمامَ هذه الأحداثِ في فرنسا. ففي عام 1792 ألَّف كتاب «انتصار المبدأ الصالح على الطالح، وبناء ملكوت الله على الأرض»، فيه يقول: «إنَّ ما يُشكلُ إقترابَ ملكوتِ الله هو التحولُ التدريجيُّ من الإيمانِ الكنسيّ إلى السيطرةِ الكاملةِ للإيمانِ التديُّنيّ» [17]. ويُخبرنا أيضاً بأنه من شأنِ الثورات تسريعُ هذا التحول من الإيمانِ الكنسيّ إلى الإيمان العقلانيّ. بهذا اكتسبَ «ملكوت الله» الذي تحدَّث عنه يسوع تعريفاً جديداً وحضوراً مختلفاً؛ فقد نشأَ ما يُمكنُ تسميتُهُ «انتظاراً فورياً»: فـ «ملكوت الله» يسودُ حيثُ يزولُ «الإيمانُ الكنسيّ» ليحلَّ مكانه «الإيمان التديُّنيّ» أي الإيمان العقلانيّ. في عام 1795 في كتابه «نهايةُ كل الأشياء» تظهرُ صورةٌ مختلفةٌ، ففيه يعتقدُ كانط أنه إلى جانب النهايةِ الطبيعيةِ لكلِّ الأشياء هناك إمكانيةُ حدوثِ نهايةٍ لاطبيعيةٍ، نهايةٍ فاسدة. فيكتب قائلاً: «إذا أتى يومٌ من الأيامِ لمْ تَعُد فيه المسيحيةُ تستحقُّ المحبةَ [...] عندها سيكونُ على فكرِ الناسِ السائد أن يتحوَّلَ إلى رفضِها ومجابهتِها؛ هكذا يبدأُ عصرٌ – ولو أنه قصير – هو عصرُ حكمِِ المسيحِ الدجّال (يُفتَرضُ أنه حكمٌ مؤسَّسٌ على الترهيب والأنانية). كنتيجةٍ لذلك، وبما أن القَدَرَ لَمْ يُساعدِ المسيحيةُ أن تصبحَ ديانةَ العالمِ – بالرغمِ من أن هذا كانَ هدفها – تكونُ هذه هي النهايةُ (الفاسدة) لجميعِ الأشياءِ من وجهةِ النظر الأخلاقية» [18].
20- استمرَّ القرنُ التاسعُ عشر في إيمانِهِ بالتطوُّرِ كشكلٍ جديدٍ من أشكال الرجاءِ للبشر، واستمرَّ في اعتبارِ العقلِ والحريةِ كدليلَينِ يجب اتباعهما في مسيرةِ الرجاء. لكن ما لبثَ أن خَلَقَ تسارُعُ التطوّرِ التقنيِّ وما تبعهُ من تحولٍ إلى الصناعةِ وضعاً اجتماعياً جديداً: فقد تشكلت طبقةُ عمالِ المصانع وما يُدعى بـ «مأجوري المعامل»، أولئكَ الذين وصف فريدريك انجِلز عام 1845 حالتَهم المزرية. كانَ واضحاً لقرّائه أنه لا يُمكنُ لهذا الوضعِ أن يستمر؛ كان من الضروريّ اجراءُ تغييرٍ ما. لكن هذا التغيير كان يُهدِّدُ بهزّةٍ تُهدِّمُ بنيةَ المجتمعِ البرجوازيّ بأكملها. بعد ثورةِ البرجوازيين عام 1789 كان الوقتُ قد حانَ لثورةٍ أخرى، ثورةُ العُمّال: فلم يكن للتطوُّرِ أن يتقدَّمَ ببساطةٍ من خلالِ خطواتٍ صغيرة. كان من الضروري أن يكونَ هناكَ تحولٌ ثوريّ.
قَبِلَ كارل ماركس هذا التحدي وبعزمِ تعابيرهِ وفكره حاولَ أن يبدأ الخطوةَ الجديدةَ الكبرى، والتي كان يعتبرُها حاسمةً في تاريخِ الخلاص، نحوَ الواقع الذي كان كانط يدعوه «ملكوت الله». هكذا وبعدَ أن قُوِّضَتْ حقيقةُ الواقعِ الروحيّ لم يعد هناك سوى الإهتمامُ بحقيقة الواقع الماديّ. فتحوَّلَ النَقدُ من السماءِ إلى الأرض، من اللاهوتِ إلى السياسة. فلم يَعُد التقدمُ في سبيلِ الإزدهارِ نحوَ عالمٍِِ صالحٍ نهائيٍّ يأتي بفضلِ العِلمِ بل بفضلِ السياسة – بفضلِ سياسةٍ مدروسةٍ قادرةٍ على التعرُّفِ على بينةِ التاريخِ والمجتمعِ لتُرشده إلى طريق الثورةِ لتغيير كل الأشياء.
لقد وصفَ ماركس، بدقةٍ بارعةٍ لم تَخلُ على كل الأحوال من الجزئيّةِ والتحيُّزِ، حالةَ عصرِه كما بيَّنَ بقدرةٍ تحيليّةٍ كبيرةٍ الطرقَ نحوَ الثورةِ بشكلٍ عمليّ وذلك من خلال الحزب الشيوعيّ الذي نشأ عام 1848 مع «الإعلان الشيوعي». إنَّ الوعودَ التي قَطَعَها كانت وما تزالُ جذّابةً، هذا بفضلِ حدَّةِ تحليلهِ وإرشاداتهِ الواضحةِ للوسائلِ التي كانت بإمكانها أن تُحدثَ التغييرَ الجذريّ. وقد تحقّقَتْ هذه الثورةُ بأكثر أشكالها جذريةً في روسيا.
21- لكن بإنتصارِ هذه الثورة ظَهر خطأُ ماركس الأساسيّ. كان قد بيَّنَ بالتفصيل كيفيةَ تحقيقِ الإنقلاب، لكنه لَم يُخبرنا كيف كان على الأمور أن تسيرَ بعد ذلك. فقد كانَ يعتقدُ ببساطةٍ أن تجريد الطبقةِ المُسيطرة من أملاكِها وما يتبعُها من سقوطِ الحكم السياسيّ وامتلاكِ الجميعِ لوسائلِ الإنتاج سيؤدي لا محال إلى تحقيقِ أورشليمِ الجديدة. حيثُ تُلغى جميعُ التناقضات والإنسانُ والعالمُ يعيشان في تناغمٍ وسلام. حيثُ تجري كلُّ الأمورِ في مسارِها الصحيحِ لأن كلَّ شيءٍ هو مِلكُ الجميع وكلُّ فردٍ يُريدُ الخيرَ للآخر. هكذا وبعدَ نجاحِ الثورةِ انتَبَهَ لينين إلى أنه ليست في مؤَلَّفاتِ معلِّمه أيةُ إشارةٍ تُبيِّنُ ما يجب فعله. نعم، بالرغم من أنَّ ماركس كان قد تكلَّمَ عن «المرحلة المتوسطة» المُتمّيزةِ بدكتاتوريةِ الطبقةِ العاملةِ، كضرورةٍ لا بديلَ عنها، إلى أن تأتي مرحلةُ زوالها.
نحنُ نعرفُ جيداً هذه «المرحلة المتوسطة» ونعلمُ كيفَ تطوَّرَت لاحقاً بشكلٍ لم ينشأ عنهُ العالمُ السليمُ بل تَرَكَ خلفهُ الخرابَ والدمار. لَم يكن خطأ ماركس الوحيد عدمَ تخطيطهِ للنُظمِ الضروريةِ للعالم الجديد، تلك التي من المُفترَض ألا تلزَمَ بعد تحقيقه، فعدمُ حديثهِ عنها هو نتيجةٌ منطقيةٌ لفكره. لكن خطأَهُ كانَ أعمقُ من ذلك: لقد نسيَ أن الإنسانَ يبقى إنساناً. لقد نسيَ الإنسانَ وحُريتَهُ، نسيَ أن الحريةَ تبقى دائماً حريةً حتى في إرتكاب الشر. لقد اعتقدَ بأن إصلاحَ الإقتصادِ يعني بالضرورة إصلاحَ كل شيء.
إن خطأَهُ الحقيقيّ هو الماديّة: فالإنسانُ ليسَ مجرّدِ نتاجِ الأحوالِ الإقتصاديةِ ومن غيرِ الممكنِ إصلاحُهُ فقط من الخارجِ بخلقِ أحوالٍ إقتصاديةٍ مؤاتية.
22- هكذا نجدُ أنفسنا من جديدٍ أمامَ السؤال: ماذا نستطيعُ أن نرجو؟ من الضروريّ على عصرِنا الحديثِ أن يُمارسَ نقدَ الذاتِ بالحوارِ مع المسيحيةِ ومع فكرتِها عن الرجاء. وعلى المسيحيينَ في هذا الحوارِ إنطلاقاً من معارفهم وخبراتهم أن يتعلّموا من جديد ماهيّةَ رجائِهم الحقيقيّ، وما بإمكانهم أن يُعطوا للعالمِ وما ليس بإمكانهم أن يُعطوه. يجب على العصرِ الحديثِ في نقدِهِ لذاتِهِ أن يلتقي مع المسيحيةِ المُعاصرةِ في نقدها لذاتها، وعلى المسيحيةِ بدورها أن تفهمَ ذاتَها من جديدٍ إنطلاقاً من جذورِها. عن هذا يمكنُنا أن نلمِّحَ بكلماتٍ موجزة. قبل كلِّ شيءٍ علينا أنْ نسألَ أنفسَنا: ما هو المعنى الحقيقي لكلمةِ «تطور»؛ ما الذي تَعِدُ بِهِ وما الذي لا تَعِدُ به؟ فمنذ القرنِ التاسع عشر كان هناكَ نقدٌ تجاهَ الإيمانِ بالتطور. في القرن العشرين عبَّر تيودور ف. أدورنو عن مشكلةِ الإيمانِ بالتطور بطريقةٍ حاسمةٍ: التطورُ، إذا ما نَظَرنا إليهِ عن قُربٍ، هو تطوُّر المِقلاع ليصيرَ قنبلة. في الواقع، هذا ليس إلا وجهاً من وجوهِ التطوُّر، وجهٌ لا يجبُ علينا إخفائُهُ وإلا أصبحَ التطوُّرُ أمراً يكتنفه الغموض. يخلقُ التطورُ، دون شكٍ، فُرصاً جديدةً للخيرِ، لكنهُ يخلق أيضاً فرصاً هائلةً للشرِ – فرصاً لم تكن موجودةً من قَبل. نحنُ جميعاً قد صِرنا شهوداً كيف أنَّ وقوعَ التطورِ في أيدٍ خاطئةٍ يمكن أن يتحوَّل وقد تحوَّل بالفعل إلى تطورٍ للشرِّ رهيب. إن لم يكن إلى جانب التطورِ التقنيّ تطورٌ في تنشئة الإنسانِ الأخلاقية، تطورٌ في نموِّ الإنسان الداخليّ (راجع أف 3 / 16؛ 2 كو 4 / 16) عندها لا يكونُ التطورُ تطوراً بل تهديداً للإنسانِ والعالم
17- مَن يقرأ هذه التصريحات ويتأملها بتمعُّن يرى فيها تحوُّلاً يقلب الموازين: حتى تلك اللحظة كانت استعادةُ الإنسانِ لما فَقَدَه بعد طَرده من الفردوس تتم بواسطةِ الإيمان بيسوع المسيح، هذا كان معنى «الفداء». أما الآن فهذا «الفداء»، أي استعادة «الفردوس» المفقود لم يَعد يُعتَبر ثمرةً للإيمانِ بل ثمرةَ العلاقةِ المُكتشفةِ بين العلم وتطبيقاته العملية. هذا لا يعني ببساطة أن الإنسانَ قد أنكرَ الإيمان؛ لكنه قد حوَّله إلى مجالٍ آخر – أي المجال الفرديّ البحت ومجال الحياة الأبدية – وهكذا أصبح الإيمان دون أهميةٍ بالنسبة للعالم. لقد رَسَمَتْ هذه النظرةُ للإيمان برنامجاً يسيرُ عليهِ عصرُنا الحاضر وما زال لها دورٌ في أزمةِ الإيمانِ الحالية، والتي هي قبْلَ كل شيءٍ أزمةَ رجاءٍ مسيحيّ. هكذا قد اكتسب الرجاءُ في مفهوم باكون شكلاً جديداً. فأصبح اسمه: الإيمان بالتطور. كان واضحاً بالنسبة لباكون أن إكتشافات واختراعات عصره لم تكن سوى البداية؛ وأنه بفضلِ التناغمِ بين العلمِ وتطبيقاتِهِ العملية ستكون هناك اكتشافاتٌ جديدةٌ جذريةٌ، وبهذا سيظهرُ عالمٌ جديدٌ تماماً، إنه ملكوتُ الإنسان [16]. هكذا قد سَبق وتحدَّث باكون عن الإختراعات المستقبلية – حتى وصل إلى الطائرةِ والغواصة. وهكذا بينما تابعت أيدولوجية التطور هذه إزدهارها لاحقاً، تعَزَّزَ إيمانُ الإنسانِ بها لأنه كان يفرحُ إذ يرى قِواهُ تتقدم بشكلٍ ملموس بواسطتها.
18- في نفس الوقت إزدادت بإستمرارٍ مِحوريةُ نقطتين في فكرةِ التطور: العقلُ والحرية. فالتطور كان يعني قبل كل شيء إزديادُ سيطرةِ العقلِ بإعتباره قدرةً على الخير ولأجل الخير. فالتطورُ يعني إذاً مسيرةً نحو الإستقلالية، تطورٌ نحوَ الحريةِ الكاملة. والحريةُ اعتُبرَت بدورها وعدٌ بهِ يُحقق الإنسانُ ذاتَهُ في مسيرتِهِ نحو الملء. فكانَ لكلتا النقطتين – الحرية والعقل – بُعدٌ سياسيّ. فالإنسانيةُ صارت تنتظرُ ملكوتَ العقلِ كحالةٍ جديدةٍ فيها تجدُ حريّتها التامة. أما الشروطُ السياسيةُ اللازمةُ لملكوتِ العقلِ والحريةِ هذا فيبدو أنها لمْ تكن ذاتَ معالمٍ واضحةٍ بشكلٍ فوريّ. فكانَ يُعتَقد أن العقلَ والحريةَ – بفضلِ صلاحِهِم الجوهريّ – قادرَين على ضمانِ جماعةٍ إنسانيّةٍ جديدةٍ وكاملة. لكن في نفسِ الوقت ومن خلالِ هذين المفهومَين الأساسيَين أي «العقل» و«الحرية» كانَ الفكرُ ينحلُّ بصمتٍ من روابطِ الإيمانِ والكنيسةِ، متضارباً معهما تماماً كتضاربِه مع أنظمةِ الدول آنذاك. فقد كانت هاتانِ النقطتانِ تحملانِ في ذاتِهِما مكنوناً ثورياً مُفجِّراً ذو قدرةٍ هائلة.
19- علينا أن نلقي نظرةً سريعةً على المرحلتَين الأساسيّتَين اللتين تشكلان مسيرةَ تحقيقِ هذا الرجاء بطريقةٍ سياسيةٍ، بسببِ أهميتهما الكبرى في مسيرةِ الرجاءِ المسيحي، في فهمهِ وديمومته.
فقد أتَتْ أولاً الثورةُ الفرنسيةُ التي حاولت أن تفرضَ سيطرةَ العقلِ والحريةِ بشكلٍ سياسيّ واقعيّ. في البداية نَظرتْ أوروبا عصرِ التنوير بإعجابٍ إلى هذهِ الأحداث، لكن فيما بَعد وأمامَ تطوراتِها جَعَلَت تفكّرُ من جديدٍ في مَعنى العقلِ والحرية.
هناكَ كتابان لعمانوئيل كانط، يُظهران جلياً ردةَ الفعلِ المزدوجةِ أمامَ هذه الأحداثِ في فرنسا. ففي عام 1792 ألَّف كتاب «انتصار المبدأ الصالح على الطالح، وبناء ملكوت الله على الأرض»، فيه يقول: «إنَّ ما يُشكلُ إقترابَ ملكوتِ الله هو التحولُ التدريجيُّ من الإيمانِ الكنسيّ إلى السيطرةِ الكاملةِ للإيمانِ التديُّنيّ» [17]. ويُخبرنا أيضاً بأنه من شأنِ الثورات تسريعُ هذا التحول من الإيمانِ الكنسيّ إلى الإيمان العقلانيّ. بهذا اكتسبَ «ملكوت الله» الذي تحدَّث عنه يسوع تعريفاً جديداً وحضوراً مختلفاً؛ فقد نشأَ ما يُمكنُ تسميتُهُ «انتظاراً فورياً»: فـ «ملكوت الله» يسودُ حيثُ يزولُ «الإيمانُ الكنسيّ» ليحلَّ مكانه «الإيمان التديُّنيّ» أي الإيمان العقلانيّ. في عام 1795 في كتابه «نهايةُ كل الأشياء» تظهرُ صورةٌ مختلفةٌ، ففيه يعتقدُ كانط أنه إلى جانب النهايةِ الطبيعيةِ لكلِّ الأشياء هناك إمكانيةُ حدوثِ نهايةٍ لاطبيعيةٍ، نهايةٍ فاسدة. فيكتب قائلاً: «إذا أتى يومٌ من الأيامِ لمْ تَعُد فيه المسيحيةُ تستحقُّ المحبةَ [...] عندها سيكونُ على فكرِ الناسِ السائد أن يتحوَّلَ إلى رفضِها ومجابهتِها؛ هكذا يبدأُ عصرٌ – ولو أنه قصير – هو عصرُ حكمِِ المسيحِ الدجّال (يُفتَرضُ أنه حكمٌ مؤسَّسٌ على الترهيب والأنانية). كنتيجةٍ لذلك، وبما أن القَدَرَ لَمْ يُساعدِ المسيحيةُ أن تصبحَ ديانةَ العالمِ – بالرغمِ من أن هذا كانَ هدفها – تكونُ هذه هي النهايةُ (الفاسدة) لجميعِ الأشياءِ من وجهةِ النظر الأخلاقية» [18].
20- استمرَّ القرنُ التاسعُ عشر في إيمانِهِ بالتطوُّرِ كشكلٍ جديدٍ من أشكال الرجاءِ للبشر، واستمرَّ في اعتبارِ العقلِ والحريةِ كدليلَينِ يجب اتباعهما في مسيرةِ الرجاء. لكن ما لبثَ أن خَلَقَ تسارُعُ التطوّرِ التقنيِّ وما تبعهُ من تحولٍ إلى الصناعةِ وضعاً اجتماعياً جديداً: فقد تشكلت طبقةُ عمالِ المصانع وما يُدعى بـ «مأجوري المعامل»، أولئكَ الذين وصف فريدريك انجِلز عام 1845 حالتَهم المزرية. كانَ واضحاً لقرّائه أنه لا يُمكنُ لهذا الوضعِ أن يستمر؛ كان من الضروريّ اجراءُ تغييرٍ ما. لكن هذا التغيير كان يُهدِّدُ بهزّةٍ تُهدِّمُ بنيةَ المجتمعِ البرجوازيّ بأكملها. بعد ثورةِ البرجوازيين عام 1789 كان الوقتُ قد حانَ لثورةٍ أخرى، ثورةُ العُمّال: فلم يكن للتطوُّرِ أن يتقدَّمَ ببساطةٍ من خلالِ خطواتٍ صغيرة. كان من الضروري أن يكونَ هناكَ تحولٌ ثوريّ.
قَبِلَ كارل ماركس هذا التحدي وبعزمِ تعابيرهِ وفكره حاولَ أن يبدأ الخطوةَ الجديدةَ الكبرى، والتي كان يعتبرُها حاسمةً في تاريخِ الخلاص، نحوَ الواقع الذي كان كانط يدعوه «ملكوت الله». هكذا وبعدَ أن قُوِّضَتْ حقيقةُ الواقعِ الروحيّ لم يعد هناك سوى الإهتمامُ بحقيقة الواقع الماديّ. فتحوَّلَ النَقدُ من السماءِ إلى الأرض، من اللاهوتِ إلى السياسة. فلم يَعُد التقدمُ في سبيلِ الإزدهارِ نحوَ عالمٍِِ صالحٍ نهائيٍّ يأتي بفضلِ العِلمِ بل بفضلِ السياسة – بفضلِ سياسةٍ مدروسةٍ قادرةٍ على التعرُّفِ على بينةِ التاريخِ والمجتمعِ لتُرشده إلى طريق الثورةِ لتغيير كل الأشياء.
لقد وصفَ ماركس، بدقةٍ بارعةٍ لم تَخلُ على كل الأحوال من الجزئيّةِ والتحيُّزِ، حالةَ عصرِه كما بيَّنَ بقدرةٍ تحيليّةٍ كبيرةٍ الطرقَ نحوَ الثورةِ بشكلٍ عمليّ وذلك من خلال الحزب الشيوعيّ الذي نشأ عام 1848 مع «الإعلان الشيوعي». إنَّ الوعودَ التي قَطَعَها كانت وما تزالُ جذّابةً، هذا بفضلِ حدَّةِ تحليلهِ وإرشاداتهِ الواضحةِ للوسائلِ التي كانت بإمكانها أن تُحدثَ التغييرَ الجذريّ. وقد تحقّقَتْ هذه الثورةُ بأكثر أشكالها جذريةً في روسيا.
21- لكن بإنتصارِ هذه الثورة ظَهر خطأُ ماركس الأساسيّ. كان قد بيَّنَ بالتفصيل كيفيةَ تحقيقِ الإنقلاب، لكنه لَم يُخبرنا كيف كان على الأمور أن تسيرَ بعد ذلك. فقد كانَ يعتقدُ ببساطةٍ أن تجريد الطبقةِ المُسيطرة من أملاكِها وما يتبعُها من سقوطِ الحكم السياسيّ وامتلاكِ الجميعِ لوسائلِ الإنتاج سيؤدي لا محال إلى تحقيقِ أورشليمِ الجديدة. حيثُ تُلغى جميعُ التناقضات والإنسانُ والعالمُ يعيشان في تناغمٍ وسلام. حيثُ تجري كلُّ الأمورِ في مسارِها الصحيحِ لأن كلَّ شيءٍ هو مِلكُ الجميع وكلُّ فردٍ يُريدُ الخيرَ للآخر. هكذا وبعدَ نجاحِ الثورةِ انتَبَهَ لينين إلى أنه ليست في مؤَلَّفاتِ معلِّمه أيةُ إشارةٍ تُبيِّنُ ما يجب فعله. نعم، بالرغم من أنَّ ماركس كان قد تكلَّمَ عن «المرحلة المتوسطة» المُتمّيزةِ بدكتاتوريةِ الطبقةِ العاملةِ، كضرورةٍ لا بديلَ عنها، إلى أن تأتي مرحلةُ زوالها.
نحنُ نعرفُ جيداً هذه «المرحلة المتوسطة» ونعلمُ كيفَ تطوَّرَت لاحقاً بشكلٍ لم ينشأ عنهُ العالمُ السليمُ بل تَرَكَ خلفهُ الخرابَ والدمار. لَم يكن خطأ ماركس الوحيد عدمَ تخطيطهِ للنُظمِ الضروريةِ للعالم الجديد، تلك التي من المُفترَض ألا تلزَمَ بعد تحقيقه، فعدمُ حديثهِ عنها هو نتيجةٌ منطقيةٌ لفكره. لكن خطأَهُ كانَ أعمقُ من ذلك: لقد نسيَ أن الإنسانَ يبقى إنساناً. لقد نسيَ الإنسانَ وحُريتَهُ، نسيَ أن الحريةَ تبقى دائماً حريةً حتى في إرتكاب الشر. لقد اعتقدَ بأن إصلاحَ الإقتصادِ يعني بالضرورة إصلاحَ كل شيء.
إن خطأَهُ الحقيقيّ هو الماديّة: فالإنسانُ ليسَ مجرّدِ نتاجِ الأحوالِ الإقتصاديةِ ومن غيرِ الممكنِ إصلاحُهُ فقط من الخارجِ بخلقِ أحوالٍ إقتصاديةٍ مؤاتية.
22- هكذا نجدُ أنفسنا من جديدٍ أمامَ السؤال: ماذا نستطيعُ أن نرجو؟ من الضروريّ على عصرِنا الحديثِ أن يُمارسَ نقدَ الذاتِ بالحوارِ مع المسيحيةِ ومع فكرتِها عن الرجاء. وعلى المسيحيينَ في هذا الحوارِ إنطلاقاً من معارفهم وخبراتهم أن يتعلّموا من جديد ماهيّةَ رجائِهم الحقيقيّ، وما بإمكانهم أن يُعطوا للعالمِ وما ليس بإمكانهم أن يُعطوه. يجب على العصرِ الحديثِ في نقدِهِ لذاتِهِ أن يلتقي مع المسيحيةِ المُعاصرةِ في نقدها لذاتها، وعلى المسيحيةِ بدورها أن تفهمَ ذاتَها من جديدٍ إنطلاقاً من جذورِها. عن هذا يمكنُنا أن نلمِّحَ بكلماتٍ موجزة. قبل كلِّ شيءٍ علينا أنْ نسألَ أنفسَنا: ما هو المعنى الحقيقي لكلمةِ «تطور»؛ ما الذي تَعِدُ بِهِ وما الذي لا تَعِدُ به؟ فمنذ القرنِ التاسع عشر كان هناكَ نقدٌ تجاهَ الإيمانِ بالتطور. في القرن العشرين عبَّر تيودور ف. أدورنو عن مشكلةِ الإيمانِ بالتطور بطريقةٍ حاسمةٍ: التطورُ، إذا ما نَظَرنا إليهِ عن قُربٍ، هو تطوُّر المِقلاع ليصيرَ قنبلة. في الواقع، هذا ليس إلا وجهاً من وجوهِ التطوُّر، وجهٌ لا يجبُ علينا إخفائُهُ وإلا أصبحَ التطوُّرُ أمراً يكتنفه الغموض. يخلقُ التطورُ، دون شكٍ، فُرصاً جديدةً للخيرِ، لكنهُ يخلق أيضاً فرصاً هائلةً للشرِ – فرصاً لم تكن موجودةً من قَبل. نحنُ جميعاً قد صِرنا شهوداً كيف أنَّ وقوعَ التطورِ في أيدٍ خاطئةٍ يمكن أن يتحوَّل وقد تحوَّل بالفعل إلى تطورٍ للشرِّ رهيب. إن لم يكن إلى جانب التطورِ التقنيّ تطورٌ في تنشئة الإنسانِ الأخلاقية، تطورٌ في نموِّ الإنسان الداخليّ (راجع أف 3 / 16؛ 2 كو 4 / 16) عندها لا يكونُ التطورُ تطوراً بل تهديداً للإنسانِ والعالم
 mmmknnعضو جديد
mmmknnعضو جديد
 رد: الرسالة العامة (بالرجاء مخلصون)6 البابا بندكتس
رد: الرسالة العامة (بالرجاء مخلصون)6 البابا بندكتس
الجمعة نوفمبر 07, 2008 9:00 am
من الضروريّ على المسيحيينَ أن يتعلّموا من جديد رجائِهم الحقيقيّ
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى