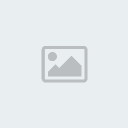محبتنا لله وللقريب(1 ) للقديس باسيليوس الكبير أسقف قيصرية الكبادوك (330-379م)
محبتنا لله وللقريب(1 ) للقديس باسيليوس الكبير أسقف قيصرية الكبادوك (330-379م)
الأحد نوفمبر 29, 2009 8:24 pm
تعاليم آبائية | محبتنا لله وللقريب(1 ) للقديس باسيليوس الكبير أسقف قيصرية الكبادوك (330-379م)  |  |
مَن قد انفكوا من هموم هذا العالم، يليق بهم أن يسهروا على حياتهم
الداخلية الخاصة بكل حرص، حتى لا يوجد قلبهم خاوياً في وقتٍ ما من الهذيذ في الله،
أو مُلوِّثاً لذكرى أعاجيبه الإلهية بالتصوُّرات الأرضية الباطلة؛ بل بالأحرى
فلينطبع الفكر المقدس في الله كخاتم على النفس بالذِّكْر الطاهر الدائم، نضعه نُصب
أعيننا في كل زمان وفي كل مكان.
لأنه عن هذا الطريق تُبادر إلينا محبة الله حتى
في أثناء تأدية أعمالنا اليومية، وتبعث فينا الحميَّة لحفظ وصايا الرب، وبالتالي
تحفظنا من الفشل أو الانحراف. مَن تملَّكت عليه الرغبة الحارة في اتِّباع المسيح،
فلا يقدر بعد أن يعود ويُحوِّل فكره إلى متعلِّقات هذه الحياة (الدنيا)، حتى ولا
إلى محبة الوالدين أو الأقارب، إذا كانت أيٌّ من هذه تتعارَض مع وصايا الرب بأيِّ
حالٍ. وبهذه الصورة نفهم القول المبارك: «إن كان أحدٌ يأتي
إليَّ ولا يُبغض أباه وأُمه... فلا يقدر أن يكون لي تلميذاً» (لو 14: 26).
وهذا ما يُعلِّمه لنا أيضاً تلاميذ الرب القديسون، يعقوب ويوحنا،
اللذان برأي واحد تركا أباهما زبدي، بل وحتى السفينة التي كانت تعتمد عليها كل
معيشتهم. ثم أيضاً متَّى الذي ترك مكان الجباية وتبع الرب، وهو الذي تخلَّى، ليس
فقط عن مكاسب مهنته، بل استهان بكل المخاطر المترتبة على ذلك...
وبولس أيضاً كان يفتخر بصليب ربنا يسوع المسيح ويقول: «الذي به قد صُلِبَ العالم لي، وأنا للعالم» (غل 6: 14)، لأنه
عندما تملأ محبة الله النفس ينتفي كل صراع. وحتى لو رَشق كل الناس هذه النفس
بسهامهم (من أي نوعٍ كانت) من أجل مَن تحبه، فسوف يكون ذلك داعياً لفرحها أكثر مما
لآلامها، لأنه إذا كان الوضع الطبيعي أن يكون لنا حب وامتنان للذين أحسنوا إلينا،
بل إذا كان من السهولة أن نتحمل أية مشقة في سبيل أن نردَّ لهم معروفهم الذي عملوه
معنا، فبأي عبارات لائقة يمكننا أن نصف عطايا الله، التي بسبب كثرة عددها نعجز عن
إحصائها؟ فهي جميلة وعجيبة، وإن تأملنا ولو في واحدة منها فلن نكفَّ عن تقديم الشكر
للمُنعِم علينا.
ولكن الله كُلِّي الخيرية، كلِّي الجود، حتى أنه لا يطلب العِوَض،
ويكتفي فقط بأن نحبه في مقابل ما أعطانا. وفي الواقع بمجرد تأملي في إحسانه - إذا
سمحتم لي أن أبوح لكم بما يجول في نفسي - ينتابني قلق رهيب مخيف، لئلا بسبب تهاون
النفس في اليقظة، أو من جراء الانهماك في الأمور الباطلة، أَسقُط من محبة الله
وأصبح عاراً للمسيح، الأمر الذي سيجعل الشيطان يتشامخ علينا ويُعيِّرنا بإهانتنا
لله وعدم مبالاتنا؛ حتى أن هذا الذي لم يخلقنا ولم يتألم من أجلنا (أي الشيطان)
سيتسلَّط علينا ويجعلنا كمشتركين في عدم طاعته هو وإهماله لوصايا الله. مثل هذه
الإهانة الموجَّهة للرب، وإعطاؤنا العلَّة للعدو لأنْ يسخر بالمسيح الذي مات من
أجلنا وقام؛ هذا أفظع عندي من آلامات الجحيم.
يليق بنا أن نحب ربنا وإلهنا بكل قوة المحبة التي فينا. وعلينا
أيضاً بالمثل أن نحب قريبنا، بل وعلينا أيضاً أن نحب أعداءنا، حتى نكون كاملين
متمثلين بلطف أبينا الذي في السموات، الذي يُشرق شمسه على الصالحين والطالحين (مت
5: 45). إنه داءٌ وبيل أن نُبدِّد قوة المحبة في أمور باطلة. وإذا كان عمل المحبة
يليق باسمها؛ فمن دواعي السخرية أن ننقر بمعول هنا، وآخر هناك؛ نغدق على هؤلاء فقط
من سخائنا، ونستبعد أولئك نهائياً من دائرة محبتنا التي يُفترض فيها أن تكون
شاملة...
لا يمكن لأي بناء أن يقوم إذا انهارت روابطه، ولا لأية كنيسة أن
تنمو وتزداد، إن لم ترتبط معاً بروابط السلام والمحبة. ليس شيء يتوافق مع طبيعتنا
مثل أن نعيش في سلام أحدنا مع الآخر، وأن نتبادل الحب والود بعضنا مع بعض، ونحن في
حاجةٍ، كل منا لمساعدة الآخر أكثر مما تحتاج إحدى اليدين للأخرى.
إني عندما أتأمل في أعضاء الجسد، وأرى أنَّ ولا واحد منها يكفي
بنفسه، فكيف أقدر أن أعتبر نفسي مكتفياً بذاتي من أجل قوام حياتي الخاصة؟ رِجلٌ
واحدة لا يمكنها أن تتحرك بأمان ما لم ترتكز على الأخرى، ولا عين واحدة ترى شيئاً
بوضوح ما لم تشترك معها العين الأخرى... ونحن نسمع بدقة أكثر عندما يأتينا الصوت من
خلال الأُذنين معاً، وقبضة اليد تكون أقوى عندما تنضم الأصابع مع بعضها. وقُصارى
القول، فإنه لا يمكن لأي شيء يعمل بالطبيعة، أو أي شيء يعمل بإرادتنا الحرَّة، بدون
توافق هذه الأعضاء التي من النوع الواحد. بل حتى صلاتنا الخاصة هي أضعف من صلاتنا
عندما تكون في شركة مع الآخرين.
لا يمكن لشيء أن يفصلنا عن بعضنا البعض ما لم نرغب نحن ذلك بمحض
إرادتنا؛ لأن لنا ربّاً واحداً، وإيماناً واحداً، ولنا نفس الرجاء الواحد، حتى لو
تصوَّرتَ نفسك رأساً، فالرأس لا يمكن أن تقول للرجلين: «لا
حاجة لي إليكما» (1كو 12: 21)... لا تدعوا مثل هذا الفكر يتسلَّط عليكم
بقولكم: ”إننا قد ابتعدنا عن المآسي التي يُقاسي منها عامة الناس. فما حاجتنا بعد
للاختلاط بالآخرين؟“ ولكن أقول لكم: ”إن الرب الذي فصل بالبحر بين الجزائر
والقارات، عاد فربط بين سكان كليهما بالمحبة“...
أتريدون أن تعرفوا ماذا تفعلون مع القريب؟ ما ترغبون أن يفعله
الآخرون لكم. أتعرفون ما هو الشر؟ هو ما لا تودُّون أن تُعانوا منه من جهة
الآخرين.
وإذا كنتم قد سمعتم من الله هذا القول: «بهذا
يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن كان لكم حُبٌّ بعضاً لبعض» (يو 13: 35)، وإذا
كان الرب عندما كان مزمعاً أن يُكمل عمل تجسُّده، ترك سلامه لتلاميذه كهبة الوداع،
بقوله: «سلاماً أترك لكم، سلامي أُعطيكم» (يو 14: 27)؛
فعليه لا يمكنني أن أقول - بدون محبة للآخرين، وبدون سلام - بقدر ما أحوزه منه فيَّ
وبقدر ما أستطيع، مع كل الناس، إنني جديرٌ بأن أُدعى تلميذاً للمسيح.
كذلك ينبغي أن تكون محبتنا هي هي لكل الناس مَشاعاً للجميع، وكما
أن الإنسان طبيعياً يهتم بكلٍّ من أعضائه، راغباً في أن يكون سائر جسده صحيحاً
بالتمام، لأن الألم في العضو الواحد يُبرِّح الجسد كله. فمَن يحب عضواً ما من أعضاء
رفقته أكثر من آخر، فهو يكشف بهذا عن نقصان محبته هو. فهناك أمران متماثلان في عدم
المنفعة للجماعة أو للأسرة: النزاع المعيب والوداد الخاص (العواطف الخاصة)، لأن
العداوة تتأتَّى من المشاحنة، والغيرة والحسد والريبة تأتي بسبب العلاقات الودية
الخاصة؛ لأنه حيثما يوجد اختلال في المساواة، تبدأ علَّة الغيرة والبَغْضَاء عند
مَن جير عليهم.
ولكن مَن يريد أن يتمثَّل تماماً بصلاح الله الذي وهب نوره للكل
بالتساوي، ويُشرق شمسه على الصالحين والطالحين على حدٍّ سواء؛ عليه أن يفيض بأشعة
محبته الدافئة على الكل سواء، لأنه حيثما تهبط المحبة وتتوارى، فبدون أدنى شك، ستحل
مكانها الكراهية. وإذا كان، حسبما يقول يوحنا (الرسول): «الله
محبة» (1يو 4: 16)، فبالتالي يكون: «الشيطان بغضة». إذن، مَن يقتني المحبة
في داخله، فالله هو الذي يكون فيه؛ وأيضاً مَن يُكِنُّ البغضاء في داخله، فالشيطان
نفسه هو الذي يحتله.
وإذا كانت هذه هي طبيعة المحبة، فعلينا أن نُظهِر نفس المحبة لكل
الناس وعلى حدٍّ سواء، ونُقدِّم لكل الناس الكرامة والوقار اللائقين بكلِّ واحدٍ.
ففي جسدنا الواحد يؤثِّر الألم في عضوٍ ما على الجسد كله، وهذا أيضاً بالرغم من أن
بعض الأعضاء أكثر أهمية من الأخرى (فالضرر الذي يلحقنا بسبب جرح في إصبع الرجل، ليس
كالذي يلحقنا من الجرح الذي يُصيب إحدى العينين، مع أن الألم الناتج عن كليهما
واحد).
وعلى هذا المثال، علينا أن نُقدِّم محبة واحدة وتعاطفاً متساوياً
لكل مَن نعيش معهم على السواء. أما أولئك المستحقون لكرامة أكثر فعلينا أن نُقدِّم
لهم الوقار اللائق بهم. ولكن بين المرتبطين برباط حياة روحية مشتركة، لا ينبغي أن
يكون هناك تعاطف أكثر مع آخر بسبب قرابة جسدية حتى ولو كان أخاً أو ابناً أو ابنة،
لأن مَن يسلك هكذا يكون مدفوعاً بالطبيعة، ومثل هذا الإنسان لم ينفكَّ بعد من
الميول الطبيعية، بل ما يزال محكوماً بالجسد. ولله المجد إلى أبد الآباد كلها،
آمين.
(1)
القريب في المفهوم المسيحي هو الذي تربطني به ضرورة اجتماعية، كأن يكون
جاراً في السكن أو زميلاً في العمل، رئيساً كان أو مرؤوساً، أيّاً كان دينه أو
مذهبه أو جنسه، ولاسيما إذا كان في حاجة إلى محبتي العملية (راجع قصة ”السامري
الصالح“، لو 10: 30-37). والذي ننشره في هذا العدد هو حديث يوجِّهه القديس باسيليوس
لأبنائه الرهبان، ولكنه نافع لكل مسيحي.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى